على من نزلت السكينة في آية الغار؟
لماذا الكيل بمكيالين عند الشيعة، أليس في قوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} قد شملت توبة السيّدة حواء (عليها السلام) أيضاً وإنْ لم يشملها الخطاب، وهذا ما قاله الشيخ الطبرسيّ في تفسيره للآية السابقة، فقال: (واكتفى بذكر توبة آدم عن ذكر توبة حواء لأنَّها كانت تبعاً له) [جوامع الجامع ج1 ص97]، فلماذا لا تشمل السكينة أبا بكر لأنَّه كان مع النبيّ محمد (صلى الله عليه وآله) في الغار، كما أشار النص القرآنيُّ: {فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ}، فتكون السكينة أيضاً شاملة له؟
الجواب
يستند هذا السؤال إلى قياس آية السكينة على آية توبة آدم (ع)، لكنّه قياسٌ مع الفارق، حيث يفترض أنَّ الآيتين تتبعان القاعدة نفسها دون وجود قرينةٍ تدلُّ على ذلك. فآية توبة آدم تدلُّ على شمول التوبة لحواء لأنَّ الحدث كان مشتركًا بينهما، كما يُفهم من قوله تعالى: {فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا} [الأعراف: 22]، وقوله: {فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيطَٰنُ عَنهَا فَأَخرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} [البقرة: 36].
فالخطاب هنا جاء بصيغة التثنية، مما يدلُّ على أنَّ كليهما كانا معنيين بالفعل والنتيجة- ومع ذلك - اقتصر ذكر التوبة على آدم (عليه السلام)؛ لكونه الطرف الأبرز في القصّة، وشمل حوّاء؛ لأنَّها تابعةٌ له في الحدث من حيث المكان، ومن حيث الفعل والمسؤوليّة. وهذا التفسير ذهب إليه جمعٌ من كبار المفسرّين من الخاصّة والعامّة، كالطبرسيّ والرازيّ في [تفسير الرازيّ ج3 ص26]، والنيسابوريّ القمّيّ في [تفسير غرائب القرآن ج1 ص265]، والزمخشريّ في [الكشّاف ج1 ص129]، وغيرهم.
أما في آية الغار، فلا توجد أيَّةُ قرينةٍ تدلُّ على شمول السكينة لشخصين، بل جاءت بصيغة الإفراد دون أنْ يسبقها أو يلحقها ما يشير إلى تعدد المخاطَبين، مما يجعل افتراض شمولها لأبي بكر ترجيحًا بلا دليل.
وفي هذا السياق، أورد الشيخ المفيد شبهةً مفادها:
أنَّ الضمير في قوله تعالى: {فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} قد يكون شاملاً للنبيّ (صلى الله عليه وآله) وصاحبه معًا، استنادًا إلى بعض الاستخدامات اللغويَّة في القرآن والشعر العربي، حيث يرد ذكر شيئين ثم تُستخدم كناية بضمير المفرد للإشارة إليهما معًا. ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، حيث استخدم الضمير المفرد "الهاء" مع أنَّه يعود على الذهب والفضة معًا. وكذلك قول الشاعر:
نحنُ بما عندنا وأنتَ بما * عندكَ راضٍ والرأيُ مختلفُ
إذ استخدم (راضٍ) بصيغة الإفراد مع أنه قصد (راضون) عند الإضافة إلى (نحن). وبناءً على ذلك، فإن قياس آية الغار على آية آدم (عليه السلام) في شمول التوبة لحواء ينبغي أنْ يكون وارداً على نحو استعمال باب الكناية والمجاز، وهو أمرٌ شائعٌ في لغة العرب وفي أسلوب القرآن الكريم.
ثم ردَّ على هذه الشبهة قائلاً:
بأنّ هذا الأسلوب البلاغي َّلا يُستخدم إلّا عند وضوح المعنى وانتفاء اللبس، أي مع القرينة الواضحة، كما في الآية المذكورة حيث دلّ السياق على شمول الضمير لكلا المذكورين.
أمّا في آية الغار، فإنّ السكينة وردت بصيغة الإفراد دون قرينةٍ تدلّ على شمولها لأبي بكر؛ إذ لم يسبق في الآية أيَّةُ إشارةٍ تفيد دخول أكثر من شخصٍ في الضمير، ولو كان الضمير يشمل الاثنين؛ لأدّى ذلك إلى غموضٍ في المعنى.
فالفرق الجوهريُّ بين آية الغار والآيات التي استُشهد بها يكمن في السياق اللغويّ، ففي الآيات التي استخدمت الكناية عن شيئين بضميرٍ واحدٍ مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا}، كان هناك سياق واضح يبيّن أنَّ الضمير يشمل الاثنين.
أما في {فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ}، فلم تسبق في الآية أيَّة إشارةٍ تدلُّ على أنَّ الضمير يجب أنْ يشمل أكثر من شخص؛ ولذلك لا يمكننا أنْ نعدِل عن ظاهر اللفظ ونشمل به شخصًا آخر دون دليلٍ قاطعٍ، فإنّ العرب لا تستخدم الكناية عن شيئين بضميرٍ واحد، ثمّ تعود مباشرةً لتستخدم ضميرًا آخر خاصًا بأحدهما فقط.
ففي هذه الآية، الضمير في قوله: {وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا} يعود بالإجماع على النبيّ (صلى الله عليه وآله). فلو كان الضمير السابق في {فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} يشمل شخصين، فهذا يعني أننا ننتقل من الكناية عن اثنين إلى الكناية عن واحد في السياق نفسه، وهو أمرٌ غير مألوفٍ في اللغة العربية ولا يوجد له نظيرٌ في القرآن أو الشعر العربيّ. [ينظر: الفصول المختارة ص46-48].
وبناءً على ما تقدّم، يتبيّن أنّ السؤال يشتمل على مغالطاتٍ منطقيّةٍ مثل: مغالطة التعميم المتسرّع: حيث يتمّ الاستنتاج من حالةٍ خاصٍّة في سياقٍ مختلفٍ (شمول التوبة لحواء) أنّ أيّ شخص يكون بصحبة آخر في موضعٍ ما يجب أنْ يشمله الحكم نفسه دون دليلٍ أو قرينةٍ تدلّ على ذلك.
ومغالطة المصادرة على المطلوب: حيث تتجلّى في الافتراض المسبق بأنّ السكينة شملت أبا بكر، ثمّ استخدام هذا الافتراض نفسه كدليلٍ لإثباته، دون تقديم أيّّة قرينةٍ مستقلّةٍ تدلّ على ذلك، فالقول بأنّ أبا بكر كان مع النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) في الغار، وبالتالي فإنّ السكينة قد شملته، يقوم على افتراض غير مبرهنٍ عليه، وهو أنّ كلّ من كان مع النبيّ في موقفٍ معيّنٍ فإنّ السكينة الإلهية تشملُه بالضرورة، وهذا هو موضع النزاع نفسه الذي يحتاج إلى إثباتٍ مستقلّ، وليس مجرد افتراضٍ مسبقٍ يُبنى عليه الاستدلال. فإنّ الآية حينما استخدمت ضمير الإفراد في قوله {فأنزل الله سكينته عليه}، فإنّ الأصل أن يُحمل الضمير على أقرب مرجعٍ له، وهو النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، ما لم تقم قرينةٌ صريحةٌ تدلّ على أنّ السكينة شملت أبا بكر أيضاً، وهو ما لا يوجد في الآية ولا في سياقها. فافتراض ذلك من دون دليلٍ هو مجرّد مصادرةٍ على المطلوب، أي افتراض صحّة المدّعى ثمّ الاستدلال به لإثباته، وهو خللٌ منطقيٌّ واضح.
وعليه، فإنّ الصواب في تفسير هذه الآية بأنْ نقول: إنّ السكينة نزلت على النبيّ (صلى الله عليه وآله) وحده، وذلك لعدّة وجوه:
أحدها: أنّ الأصل في النص القرآني أن يُحمل على ظاهره ما لم تقم قرينةٌ على المجاز.
وثانيها: أنّ الضمائر السابقة واللّاحقة في الآية تعود إلى النبيّ (صلّى الله عليه)، كما هو واضحٌ في مواضع من القرآن الكريم مثل {إِلَّا تَنْصُرُوهُ}، و{نَصَرَهُ}، و{أَخْرَجَهُ}، و{يَقُولُ}، و{لِصَاحِبِهِ}، و{أَيَّدَهُ}. وعليه، فإنّ إرجاع الضمير في {عليه} إلى أبي بكر، دون وجود قرينةٍ واضحةٍ يُعَدّ ترجيحاً بلا مرجّح وخلاف الظاهر، ويفتقر إلى أيّ أساسٍ علميٍّ سليم. [ينظر: تفسير الميزان ج9 ص279].
وثالثها: تتناول الآية سياق نُصرة الله لنبيّه في ظرفٍ تعذّر فيه على أيّ أحدٍ أنْ ينصره، حيث يقول الله تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}. ويُعدّ إنزال السكينة والتأييد بالجنود غير المرئيّة من مظاهر هذه النصرة الإلهيّة، وهو ما يدلّ على أنّ إنزال السكينة مختصٌّ بالنبيّ (صلّى الله عليه) [ينظر: تفسير الميزان ج9 ص280].
ورابعها: تحمل الآية وحدةً سياقيّةً متكاملةً، حيث تأتي الجملة الختاميّة: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا} في سياق بيان المعنى العامّ للآية؛ إذ تشير {كَلِمَةُ اللَّهِ} إلى وَعْدِهِ بالنُّصرة، بينما ترمز {كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا} إلى سعي المشركين للقضاء على النبيّ. وهذا يستلزم أنْ يكون السياق السابق قد تضمّن ذكر نصرة الله للنبيّ (صلّى الله عليه وآله)، بحيث تأتي الجملة الأخيرة تأكيداً لهذه النصرة وبياناً لعلوّ كلمة الله. [ينظر: تفسير الميزان ج9 ص282].
وعلى العكس من ذلك، فلو فُرض أنّ الضمير في {عليه} يعود إلى أبي بكر، لأدّى ذلك إلى تَبِعاتٍ غير مقبولةٍ، إذ إنّ الجملتين {وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} و{فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} مترابطتان في وحدةٍ سياقيّةٍ واحدة، ممّا يقتضي رجوع الضمير في كِلتا الجملتين إلى الشخص نفسه. ومن المعلوم أنّ الضمير في {وَأَيَّدَهُ} لا يمكن إلَّا أْن يعود إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وبالتالي فإنّ القول بعودته في {عليه} إلى أبي بكر يُفضي إلى تفكيك غير منطقيٍّ للسياق، وهو ما يجعله تأويلًا غير سليمٍ من الناحية اللغويّة والتفسيريّة.
هذا وإنّ العديد من مفسّري أهل السنّة، مثل المراغيّ في [تفسير المراغيّ ج10 ص122]، وابن كثير في [تفسير القرآن ج4 ص136]، والطنطاويّ في [التفسير الوسيط ج6 ص293]، صرّحوا بأنّ هذه الجملة من الآية تتحدّث عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) وليس عن أبي بكر، ممّا يؤيّد التفسير القائل بأنّ السكينة نزلت على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) وحده.
ومنه يتّضح أنّ هذه الآية لا تثبت أيَّة فضيلةٍ خاصّةٍ لأبي بكر، بل تؤكّد أنّ النصر كان من عند الله وحده، وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) هو الذي نزلت عليه السكينة في هذا الموضع.
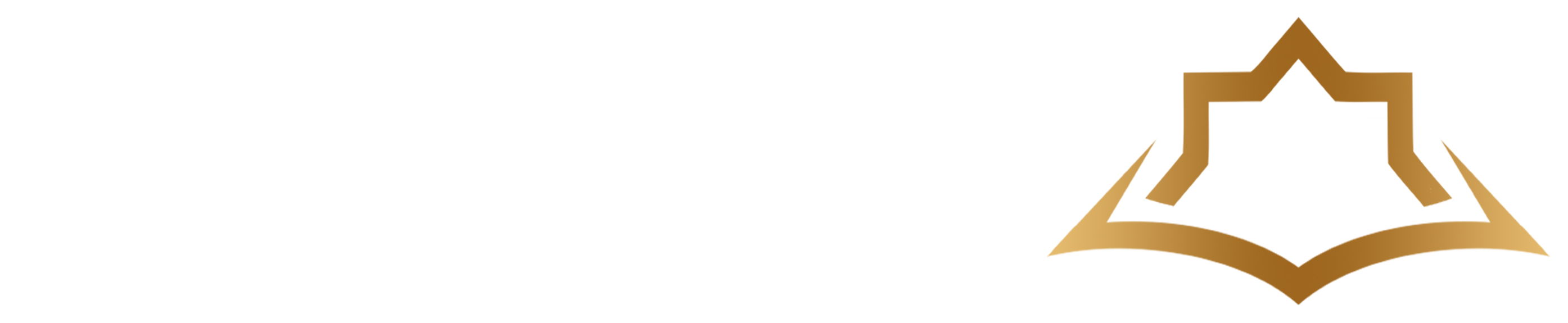


اترك تعليق