التعدّديَّة الدينيَّة
ما معنى قوله تعالى: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}، حيث يستدل البعض بهذه الآية على أنَّ الاختلاف في الأديان والعقائد أمرٌ طبيعيٌّ ولا ينبغي أنْ يكون سبباً للعداء والبغض بين الناس، والناس أحرارٌ فيما يختارونه من أديان؟
الجواب
يعتقد أنصار التعدّديَّة الدينيَّة أنّ تنوّع الأديان وطرقها يعكس مشيئة الله وإرادته، حيث إنّ الاختلاف في الطبائع البشريّة والعيش في أزمنةٍ وأماكن متباينةٍ يؤدّي بالضرورة إلى تعدّد الطرق التي يتواصل بها البشر مع الله، وفقاً لهذا الفهم، أرسل الله الأنبياء بأديانٍ مختلفةٍ تتناسب مع ظروف كلّ أمة، وقد أشار أحد الكتّاب إلى ذلك بقوله: (إنّ أوّل من غرس بذرة التعدّديَّة في العالم هو الله ذاته؛ إذ أرسل أنبياء متنوّعين، وظهر لكلٍّ منهم بوجهٍ مختلف، ووضع على كلٍّ منهم تفسيرًا يتناسب مع مجتمعه وزمانه، وبهذا اشتعلت شعلة التعدّديَّة الدينيَّة) [الصراطات المستقيمة ص18].
وبناءً على هذه الآية وغيرها الواردة في هذا المضمون، يفسرّون تعدّد الرسالات بأنَّه جزءٌ من إرادة الله وحكمته، حيث كان الناس أمّةً واحدةً في البداية، لكن تطوّر الزمن واحتياجات البشر اقتضت وجود التنوّع في الشرائع.
غير أنّ الإشكال الجوهريّ في استنادهم إلى التعدّديَّة من خلال هذه الآية وما يشابهها، يتمثّل في تجاهلهم مضامين الآيات السابقة واللاحقة، إذْ يتّضح من سياق الآيات السابقة أنّ الآية المذكورة تسعى إلى توضيح اختلاف الناس في الدين؛ إذ يخاطب الله تعالى نبيّه الكريم (صلى الله عليه وآله) لتثبيته وتخفيف حزنه بسبب عدم إيمان المشركين برسالته. يذكّره بأن حال هؤلاء المشركين مشابهٌ لأحوال آبائهم وأقوامهم السابقة، الذين أعرضوا عن الدين الحقّ، حيث قال تعالى {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ} [هود: 109ـ110]، غير أنّ الهدف من ذكر هذا الاختلاف ليس تأييدهم أو إقرارهم، بل الإشارة إلى ما ينتظر هؤلاء من العذاب يوم القيامة نتيجة انحرافهم عن الطريق المستقيم.
ولتأكيد هذا المعنى، يشير الله تعالى إلى ما حدث مع بني إسرائيل بعد أن أُنزِل على نبيّهم موسى (عليه السلام) الكتاب السماويّ، حيث اختلفوا فيه وانحرفوا عن تعاليمه، ممّا يبيّن أنّ هذا النمط من الاختلاف ليس بجديد، بل هو سنّةٌ تتكرّر في تاريخ الأمم. وفي ختام الآية، يذكّر الله تعالى نبيّه بأنّ الكافرين قد مُنحوا فرصةً في هذه الدنيا، لكنّهم سيُحاسبون على اختيارهم في الآخرة.
وبناءً على ذلك، فإنّ الآية تشير إلى أنّ اختلاف الناس في الدين هو أمرٌ واقعٌ بإرادة الله سبحانه، حيث أعطاهم حريّة الاختيار في السير نحو الحقّ أو الابتعاد عنه. ومع ذلك، فإنّ إرادة الله لم تكن بجعل الناس جميعاً متّفقين على دينٍ واحدٍ قسراً، بل شاء أن يكون اختلافهم وسيلةً لاختبارهم في اتّباع الحقّ، وهو ما أدّى إلى ظهور هذا التنوّع في الأديان والمذاهب.
ومع أنّ الآية تتحدّث عن التعدّديَّة الدينيَّة كواقع، إلّا أنّها لا تدلّ بأيّ شكلٍ على تأييد حقانيّة هذه الأديان المختلفة.
ويبدو أنّ دعاة التعدّديَّة الدينيَّة قد أخطأوا في فهم الآية، حيث خلطوا بين الإشارة إلى وجود التنوّع الدينيّ، وبين الإقرار بصحّته أو حقانيّته. بل إنّ سياق الآيات السابقة واللاحقة، فضلاً عن غيرها من آيات القرآن، يبيّن بوضوح رفض هذه الفكرة وإبطالها.
وبعبارةٍ منطقيّةٍ أنّ الاستدلال بالآية {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [هود: 118] لإضفاء الشرعيّة على التعدّديَّة الدينيَّة المطلقة أو لتبرير صحّة جميع الأديان ينطوي على مغالطتين منهجيّتين واضحتين:
المغالطة الأولى: الاستشهاد الجزئيّ المُبتزّ أو الانتقاء، وهي تعتمد على انتقاء جزءٍ من النصوص أو الأدلّة لدعم رؤية معيّنة، مع تجاهل سياقها الكامل أو البيانات التي تعارضها. فالآية عند النظر في سياقها لا تشير إلى أنّ الاختلاف مقصود لذاته، أو دليلٌ على صحّة جميع الأديان، بل تُظهر أنّ هذا الاختلاف يمثّل اختباراً إلهيَّاً لتمييز المؤمنين المتّقين عن الضالّين، كما يوضّح قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً}، حيث يُشير إلى أنّ الله خلق البشر ووهبهم حريّة الاختيار بين الإيمان والكفر، وليس لتبرير انحرافهم عن الفطرة أو اعتبار جميع المعتقدات على قدم المساواة.
المغالطة الثانية: الخلط بين الواقع والحجيَّة (تأكيد النتيجة أو خطأ العكس)، وتعني أنّ الاستدلال على مشروعيّة أو صحّة أمرٍ ما بمجرّد وجوده في الواقع، فيُستدلّ على صحّة جميع الأديان بوجود التنوّع الدينيّ في الواقع، في حين أنّ القرآن الكريم يعترف بوجود هذا التنوّع باعتباره سنّةً اجتماعيّةً ناتجةً عن حريّة الإرادة، لكنّه يؤكّد أنّ الحقّ واحدٌ لا يتعدّد، وهو الإسلام المبنيّ على التوحيد وولاية أهل البيت (عليهم السلام)، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19].
وقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير هذه الآية قوله: «الناس مختلفون في إصابة القول وكلّهم هالك، فقيل له: قوله: {إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ}؟ فقال: هم شيعتنا، ولرحمته خلقهم». [الكافي ج1 ص429].
وقد ذهب كبار المفسرّين - كقتادة والطوسيّ والطبرسيّ والطباطبائيّ - إلى هذا التفسير، حيث اتّفقوا على أنّ الآية تبيّن اختلاف الناس في الدين كواقع بإرادة الله، لكنّها لا تُقّر بشرعيّة هذا الاختلاف أو تدعو إلى القبول به كحقيقةٍ دينيّةٍ [راجع: التبيان ج6 ص83، مجمع البيان ج3 ص303، الميزان ج11 ص45 و61].
فالآية الكريمة تؤكّد أنّ الاختلاف في العقائد نتيجةٌ حتميّةٌ لحريّة الإرادة الإنسانية، وتُقرُّ بوجود الاختلاف كواقعٍ تاريخيّ (كالاختلاف بين الأمم السابقة)، لكنّها لا تُشرّع الضلال، ولا تجعله مبرّراً للتقاعس عن الدعوة إلى الحقّ.
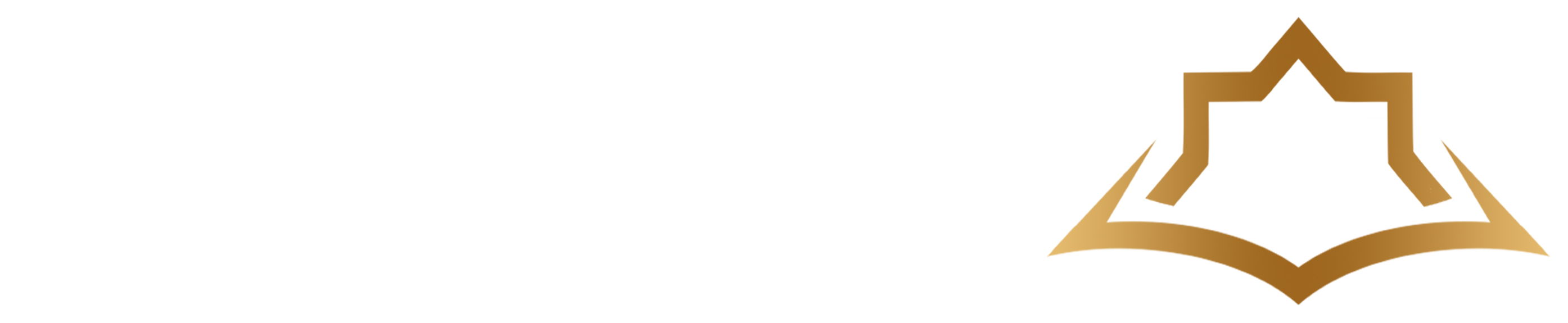


اترك تعليق