ثقافة الثأر.. تأسيس إسلامي أم موروث جاهلي؟
هل ثقافة الثأر من تأسيسات الإسلام ولها جذور في تشريعاته؟ أم أنّها من مواريث الجاهلية؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أخي السائل الكريم أنّه ليس كلّ ما كان في زمن الجاهليّة يعدّ عملاً قبيحاً، فهنالك الكثير من الأعراف والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعيّة والأخلاقيّة التي أدركها الجاهليّون إن كان بمقتضى فطرتهم وعقولهم، أم عن طريق النبوّات السابقة، مثل الكرم، والغَيرة على الأعراض، وحُسن الجوار، واجتناب بعض رذائل الأخلاق، ونحو ذلك ممّا حفلت به كتب التاريخ من أدبيات لهم، ومثل هذه الأمور لم يجد الإسلام فيها ما يمنع من قبولها، بل وجدها من الفضائل لذا تلقّاها بالقبول وأمضاها لما لها من آثار إيجابيّة فرديّة ومجتمعيّة.
والثأر إجمالاً كان واحداً من الأعراف الاجتماعيّة السائدة منذ القدم، وقد أمضاه الإسلام، ولكن ليس على نحو الإطلاق بل لما كان منطقيّاً ومبرّراً من أنواعه؛ إذ الإسلام يرى أنّ الثأر على ثلاثة أنحاء:
الأوّل: الثأر بالمعنى الأعمّ وهو ما كان متعارفاً عليه في المجتمعات الجاهليّة، بأن يجعلوا لقبيلة المُجنى عليه (المقتول) حقّ الانتقام من الجاني أو ممَّن يتّصل به بسبب أو نسب من قبيلته؛ إذ لم يكن لهذا الانتقام حدود ولا ضوابط، فقد يُقتل رجل واحد فتهدّد قبيلته من كافة أفراد قبيلة القاتل وتعتبرهم جميعاً مسؤولين عن مقتله، حتّى إنّها لتقتل العشرة بالواحد من أبنائها.
ومن الواضح أنّ العقل يحكم بقبح أخذ البريء بذنب الجاني، وكذلك الشارع المقدّس، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ؛ ولذا اعتبر الإسلام هذا النوع من الثأر محرّماً في شريعته ورفضه رفضاً قاطعاً بوصفه واحداً من الأعراف الجاهليّة المقيتة التي يقول عنها النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله): «أَلا وكلّ مأثرة أو بدعة كانت في الجاهلية أو دم أو مال فهو تحت قَدمَيَّ هاتين »[تفسير القمّي ج1 ص171].
الثاني: الثأر بالمعنى الخاصّ، وهو الثأر التشريعيّ المجعول لكافّة الناس، بأن يكون لأولياء المُجنى عليه حقّ أخذ الثأر من الجاني بخصوصه دونما أحد سواه مهما كانت درجة قرابته منه، وهذا المعنى هو المسمّى شرعاً بالقصاص، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 178- 179].
لم يكن هذا النوع من الثأر متولّداً في الإسلام، بل كان منصوصاً على مشروعيّته في الشرائع السماويّة السابقة أيضاً كاليهوديّة والنصرانيّة، قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 44- 47]. ومثل هذا التشريع منشؤه حكم العقل والعقلاء بقبح الاعتداء على الآخرين بقتل أو جرح أو نحوهما وذمّ المعتدي ولزوم معاقبته؛ لذا أمضاه الشارع المقدّس بوصفه سيّد العقلاء.
والإسلام سلك في هذا النوع من الثأر مسلكاً وسطاً بين الإلغاء والإثبات، حيث جعل ولي المقتول مخيّراً بين ثلاثة أمور: (فإمّا أن يقتصّ من الجاني بمقدار جنايته لا أكثر، أو يعفوَ عنه مع أخذ الديّة منه إنْ رضي الجاني بدفعها، أو يعفوَ عنه بلا مقابل)، فالإسلام يُثبت حقّ الاقتصاص، لكنّه يلغي تعيّنه ووجوبه، فلم يحصر معالجة الجناية بخصوص الثأر، كما أنّه لم يجعل شيئاً من الأمور الثلاثة على نحو اللزوم والوجوب، وإنّما جعل ذلك كلّه حقّاً من حقوق المُجنى عليه وأوليائه فلهم أخذه ولهم إسقاطه، فإنّ الناس مسلّطون على أنفسهم وأموالهم. لكن يلاحظ أنّهم متى اختاروا العفو مع أخذ الدية أو بدونها لم يَجُزْ لهم شرعاً التعدي بعد ذلك، خلافاً للجاهليّين الذين كانوا يقتلون القاتل أحياناً حتّى بعد العفو وأخذ الدية. [ينظر: تفسير الميزان ج1 ص434، تفسير الأمثل ج1 ص503].
من هنا يتبيّن لنا أن تشريع الثأر بهذا المعنى - أي بمعنى القصاص - ليس تشريعاً للانتقام، وإنّما هو وسيلة ضبط وقائية تحدّ من إقدام المجرمين على ارتكاب جرائمهم العدوانيّة فتحفظ لهم نفوسهم ونفوس مَن يريدون قتلهم وحياة المجتمع ككلّ، كما أنّها وفي نفس الوقت تعالج الثأر بمفهومه الجاهليّ وتقضي عليه، وأيضاً تهدئ من فورة الغضب التي لدى وأولياء الدم؛ إذ لو بقيت فلربّما أدّت إلى نزاعات وصراعات لا تُحمد عقباها فإنّ ثقافة الثأر ليست وليدة الساعة بل هي ثقافة متجذّرة وُلدت مع ولادة الإنسان فكان لابدّ من ضبطها وتنظيمها على هيئة قانون معيّن، وبالتالي صار واضحاً مدى الحاجة إلى مثل هذا التشريع، وإلّا عمّت الفوضى واستشرى الفساد في الأرض، ولا دليل أدلّ على ذلك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترة قصيرة ، في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام مكتفية بسجن مرتكبي جرائم القتل في أماكن كثيراً ما تكون أفضل من بيوتهم الذي كان يقطنه. [ينظر: تفسير الأمثل ج1 ص501].
والحاصل: أنّ نتائج هذا التشريع تنعكس بطبيعتها إيجابيّاً على حياة المجتمع الإنسانيّ حيث يضمن العمل به حياةً آمنة يتدنّى فيها منسوب الجريمة إلى حدّ بعيد؛ إذ لولا هذا التشريع ونظائره لما أمكن أن تشيع ثقافة التعايش السلمي، ولتعرّضت حياة الكثير من الناس إلى الخطر، واضطرب نظام المجتمع، روى الطبرسيّ عن أبي خالد الكابليّ عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في تفسير قوله تعالى : {لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ..} - قال: « ولكم - يا أمّة محمّد - في القصاص حياة؛ لأنّ من هَمَّ بالقتل فعرف أنّه يُقتصُّ منه فكَفَّ لذلك عن القتل، كان حياة للذي هَمَّ بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس» [الاحتجاج ج2 ص50].
الثالث: الثأر بالمعنى الأخصّ، وهو الثأر المترتّب على قتل أحد من أولياء الله تعالى بنحو يستند فيه إلى أسباب دينية وعقائديّة محضة، كما في قتل الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)؛ بسبب أدائهم لوظائفهم المنوطة بهم من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشادة الدين وإماتة البدع، وإقامة العدل ومحاربة الظلم والفساد، وإحقاق الحقّ ودحض الباطل، وبالتالي فإنّ قتل هؤلاء الصالحين المصلحين ثمّ الثأر لهم يكون مندرجاً ضمن سلسلة حلقات الصراع المستمرّ بين حزب الله وحزب الشيطان؛ لذا يكون لهذا النوع من الثأر خصائص تميّزه عن النوعين السابقين، منها مثلاً:
1ـ أنّ ولي الدم فيه هو الله تعالى وسائر عباده الصالحين، أي أنّ الثأر هنا ليس ثأراً شخصيّاً، بل هو ثأر سماويّ يقوم على أسس ومبادئ رساليّة؛ ومن هنا جاء في زيارات سيّد الشهداء الحسين: «السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره».
2ـ أنّ الله تعالى قد يثأر فيه لأنبيائه وأوليائه بشكل مباشر ومن دون تدخّل أحد من خلقه، فينتقم من المجرمين بواسطة آية من آياته التكوينيّة، وقد يُسند مهمّة ذلك إلى عباده الصالحين في الأرض من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المؤمنين، كما هو شأن الثأر لسيد الشهداء الحسين (عليه السلام) على يد المهديّ المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وأنصاره، روى الكلينيّ عن محمّد بن حمران، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما كان من أمر الحسين بن علي ما كان، ضجت الملائكة إلى الله تعالى، وقالت: يا ربّ يُفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبيّك ؟! قال: فأقام الله لهم ظلَّ القائم (عليه السلام) وقال: بهذا أنتقم لهذا » وفي لفظ آخر: « بهذا أنتقم له من ظالميه » [الكافي ج1 ص465، أمالي الطوسي ص418] وجاء في زيارات سيّد الشهداء (عليه السلام): « فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله »، وجاء أيضاً: «وأسأله أن يبلّغني المقام المحمود لكم عند الله ، وأن يرزقني طلب ثأركم [ثأري] مع إمام مهديّ ظاهر ناطق منكم». كما يمكن أن يحقّق هذا النوع من الثأر بواسطة من لا حظَّ له في الآخرة، بأن يسلّط بعض الكافرين على الجناة يسومونهم القتل وسوء العذاب، كما حصل في انتقامه تعالى ليحيى بن زكريا (عليهما السلام) بتسليطه بخت نصّر على بني إسرائيل. [ينظر: مناقب ابن شهرآشوب ج3 ص237]
3ـ بما أنّ قتل أولياء الله تعالى قد وقع على أساس انتمائهم وولائهم وعقيدتهم فقد أصبح هذا النوع من الثأر متوجّهاً إلى الجاني والراضي بالجناية معاً؛ والسرّ في ذلك يرجع إلى اجتماعهما في الولاء للشيطان وانضوائهما تحت لوائه، فمن الواضح أنّه لولا هذا الاجتماع لما كان للشيطان حزب ومعسكر ولا أمكن له سفك دماء الصالحين في الأرض؛ لذا يتوجّه الثأر إلى الجاني ومَن تلقّى جنايته بالقبول والرضا على حدّ سواء، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أيها الناس، إنّما يجمع الناس الرضا والسخط. وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لَمَّا عموه بالرضا، فقال سبحانه: {فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ}، فما كان إلّا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكّة المحماة في الأرض الخوّارة » [نهج البلاغة ص319]، هذا مع أنّ ثمود لم يقتلوا إلّا ناقةً وفصيلها، ولكن بما أنّها آية الله لهم فقد هلكوا بجرمهم هذا، فما بالك بمن يقتل أولياء الله تعالى وخاصّته وخيرته من خلقه وآياته للعالمين جميعاً؟! فإنّ الله تعالى أسرع نصرة إلى أوليائه تكويناً وتشريعاً.
من خلال أمثلته السابقة يظهر لنا أنّ هذا النوع من الثأر لم يكن هو الآخر من وضع الإسلام وتأسيساته، وإنّما هو سنّة إلهية جرت في هذه الأمّة على نحو ما كانت جارية في جميع الأمم والحضارات الأخرى، وهي سنّة وضعتها السماء؛ لأجل أن تبقى كلمة الله هي العُليا، كما أنّه يمثّل نوعاً من ردّ الاعتبار لأولياء الله تعالى وخاصّته من خلقه؛ إذ لا ملجأ لهم سواه تعالى ولا مغيث دونه، جاء في مزامير داود (عليه السلام): «خاصم يا ربّ مخاصمي. قاتل مقاتلي * أمسك مجناً وترساً وانهض إلى معونتي * وأشرع رمحاً وصدّ تلقاء مطاردي» [سفر المزامير: 35].
والنتيجة من كلّ ما تقدّم: أنّ الإسلام لم يؤسّس لأيّ نوع من أنواع الثأر المتقدّمة وإنّما هي موجودة أساساً، فأمضى ما هو منطقيّ ومعقول ومبرّر منها وفقاً لضوابط وتشريعات خاصّة، كما منع ممّا عدا ذلك. ختاماً هذا ما وفّقنا الله تعالى لتحريره في المقام، والحمد لله ربّ العالمين.
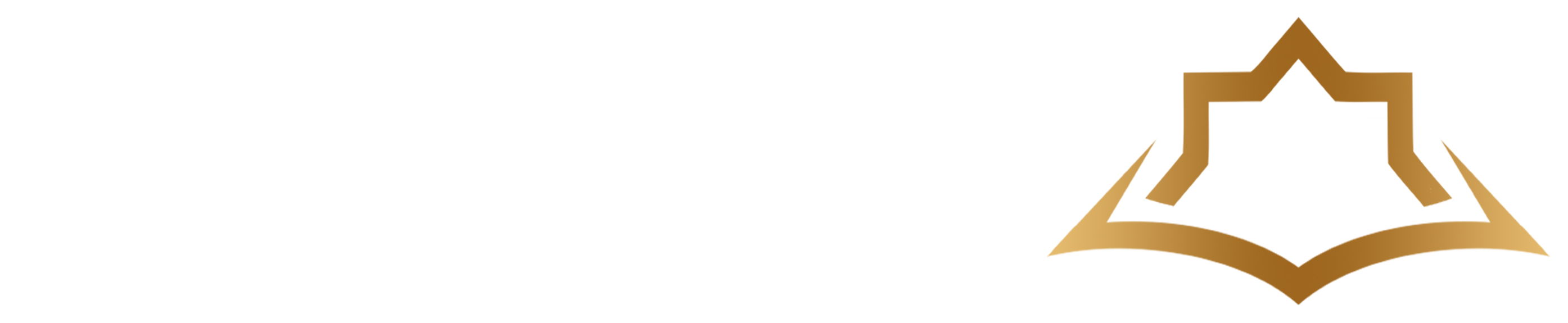


اترك تعليق