الحكمة من خروج الإمام الحسين (ع) بالعيال
ما مدى أهميّة اصطحاب الإمام الحسين (عليه السلام) لعياله معه في نهضته؟ وهل تقف وراء ذلك حكمةٌ معيّنة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل الإجابة عمّا ورد في السؤال لابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار ثلاث مقدّماتٍ دخيلةً جدّاً في الموضوع:
إحداها: أنّ النهضة الحسينيّة بحركاتها وسكناتها كانت خاضعة للتوجيه الإلهيّ والتخطيط الربّانيّ [فاجعة الطفّ ص14]، ويشهد لذلك قول الحسين (عليه السلام) حول موضوع العيال: «إنّ الله قد شاء أن يراهُنَّ سبايا» [اللهوف ص40].
والثانية: كونه (عليه السلام) إماماً معصوماّ ووارثاً للرسل والأنبياء (عليهم السلام) كما هو صريح زيارة وارث.
والثالثة: إحاطة الحسين (عليه السلام) بالتأريخ إحاطةً توازي في حجمها وعمقها ما كان لأبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي يقول: «إنّي وإنْ لم أكنْ عمَّرت عُمُر من كان قبلي، فقد نظرتُ في أعمالهم، وفكّرتُ في أخبارهم، وسرت في آثارهم حتّى عُدت كأحدهم. بل كأنّي بما انتهى إليَّ من أمورهم قد عَمّرت مع أولهم إلى آخرهم!» [نهج البلاغة ص393].
ممّا يعني أنّ الحسين (عليه السلام) كان عارفاً بكلّ ما تقتضيه النهضة الإصلاحية من عوامل للنجاح، وبكلّ ما لدى الطغاة من وسائل وأساليب يستعملونها في مواجهة عمليّة الإصلاح هذه.
وللعلم فإنّ الإمام الحسين (عليه السلام) ليس أوّل مصلحٍ ترتبط حركة عياله بحركته الرساليّة؛ فقد ذكر القرآن الكريم من قَبله جدّه إبراهيم الخليل ولوطاً وموسى وغيرهم من الأنبياء (عليهم السلام أجمعين) الذين كان عيالهم يتحرّكون بتحرّكاتهم، بل في سيرة جدّه المصطفى (صلّى الله عليه وآله) ما يكفينا شاهداً على ذلك حيث ارتبطت حركة زوجاته وابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام) بحركته عند الهجرة كما لا يخفى.
إذا عرفتَ ذلك، فنقول: يمكننا تقسيم العوامل التي تقف وراء الخروج بالعيال إلى قسمين، فمنها عوامل وقائيّة، ومنها علاجيّة، وإليك بيانها باختصار:
1- العوامل الوقائيّة: وأبرزها عاملان:
العامل الأوّل: الحفاظ على النهضة من الإجهاض أو الوأد:
فلقد وجد الإمام الحسين (عليه السلام) في تأريخ الأمم السالفة أنّ من بين أبرز السياسات العامّة للطغاة والجبابرة ضدّ الحركات الإصلاحيّة للأنبياء (عليهم السلام)، هي استخدام العيال كورقةٍ لممارسة الضغط عليهم وعلى أتباعهم؛ لأجل التراجع عن الدعوة وترك الإيمان بها، قال تعالى:{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} [الأعراف: 127]، ومثل هذه السياسة مارسها الحزب القرشيّ ضد الرعيل الأوّل من الصحابة، وما شهادة والدَي عمّار بن ياسر (ياسر وسميّة) إلّا خير شاهدٍ على ذلك.
فلا يبعد - والحال هذه - أنْ يقوم بنو أميّة القيام بمثل ذلك فيما لو خرج الحسين (عليه السلام) للنهضة وترك عياله في المدينة؛ لأجل أنْ يتراجع عن نهضته، بل والإكراه على بيعة الطاغية يزيد، فإنّ مثل ذلك غير بعيد عن أخلاق الأمويّين ووضاعتهم كما يشهد به ما حصل يوم العاشر من المحرّم حينما ألحقوا بمخيّم النساء الأذى، حتّى قال (ع): «ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان، إنْ لم يكن لكم دينٌ وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم إنْ كنتم عرباً كما تزعمون، فناداه الشمر (لعنه الله): ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال: إنّي أقول: أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهنَّ جناح فامنعوا عتاتكم وجهّا لكم وطغاتكم من التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً» [اللهوف ص71].
العامل الثاني: صيانة أهداف النهضة ورموزها:
حيث يثير القرآن الكريم تساؤلاً مهمّاً عن أهمّ القواسم المشتركة بين الطغاة وعلى مرّ التأريخ في مواجهاتهم مع الحركات الإصلاحيّة للأنبياء (عليهم السلام) حتّى يخال لك أنّهم يتواصون بها فيما بينهم، فهم من جهةٍ يعمدون إلى تشويه سمعة القائم بالدعوة والاستهزاء به، فيقول تعالى: {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} [الذاريات: 52 – 53]، ومن جهةٍ أخرى تراهم يقومون بتكذيب دعوته بزعم أنّها خلاف المشيئة الإلهيّة الداعمة لهم؛ ولذا أخبر القرآن بموقف مشركي العرب قبل صدوره منهم فقال تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ..الآية} [النحل: 35] ، وبهذين القاسمَين المشتركَين كان الناس ينفّرون عن الأنبياء.
فإذا عرفت ذلك، فلقد سعى بنو أميّة إلى تضليل المسلمين وإيهامهم بأنّ الحسين (عليه السلام) رجلٌ خارجيٌّ بغى على خليفة الأمّة يزيد، وأنّ خروجه هذا مجرّد اجتهادٍ خاطئٍ منه سببه الطمع في المُلك، ولو كان خروجه بمشيئةٍ من الله تعالى لما خسر المعركة، ولما اتّسقت الأمور لبني أميّة!، فقد روى ابن كثير وغيره أنّ يزيد لمّا رأى رأس الحسين قال: «أتدرون من أين أُتِيَ ابنُ فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل؟ وما الذي أوقعه فيما وقع فيه؟ قالوا: لا ، قال: يزعم أنّ أباه خيرٌ من أبي، وأمّه فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) خيرٌ من أمّي، وجدَّه رسول الله خيرٌ من جدّي، وأنّه خيرٌ منّي وأحقّ بهذا الأمر منّي، فأمّا قوله: أبوه خيرٌ من أبي فقد حاجّ أبي أباه إلى الله عزّ وجلّ، وعلم الناس أيّهما حُكم له، وأما قوله: أُمّه خير من أمّي فلعمري إنّ فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) خيرٌ من أمّي، وأمّا قوله: جدُّه رسول الله خيرٌ من جدّي ، فلعمري ما أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر يرى أنّ لرسول الله فينا عِدلاً ولا نَدّاً، ولكنّه إنّما أُتِيَ من قلة فقهه لم يقرأ: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ} وقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ}!!» [البداية والنهاية ج8 ص212، جواهر المطالب ج2 ص293].
فمن أجل تحصين النهضة ورجالاتها من الوقوع ضحيّةً للإعلام المعادي؛ كان لابدّ من وجود من يكمل الفصل الثاني من فصولها عن طريق جهاد الكلمة، فقد قال النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله): «أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر» [مسند أحمد 3 ص19]، وإفهام الأجيال أنّ خروج الحسين (عليه السلام) بعياله نظير خروج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلى المباهلة بأهل بيته (عليهم السلام) فإنّه خروج رساليّ كاشفٌ عن كون النبيّ لا علاقة له بطلب الدنيا أو الملك والسلطة، فكذلك في خروجه (عليه السلام)، ثمّ لا يخفى ما تبع ذلك من دَور العقيلة زينب (عليها السلام) في مواجهة طواغيت بني أميّة في عقر دارهم ودحض مزاعمهم وفضح أكذوبتهم أمام الملأ ونقل الحقائق كما هي للناس؛ ليمتاز بذلك الحقّ من الباطل والهدى من الضلال على مرّ العصور.
2- العوامل العلاجيّة: ونكتفي بذكر عاملين من بينها:
العامل الأوّل: معالجة حالة النفاق وظاهرة الروح الانهزاميَّة لدى الأمّة:
فمن خلال نظرةٍ خاطفةٍ إلى تأريخ المسلمين ومواقفهم من الجهاد في سبيل الله - قبل قيام النهضة الحسينيّة المباركة - يتّضح لنا جليّاً أنّ الطابع الغالب عليهم هو هيمنة الروح الانهزاميّة حتّى لقد مرضت قلوبهم ومردوا على النفاق، وليس هنالك من سببٍ إلّا ركونهم إلى الحياة الدنيا وملذاتها وحرصهم على أنفسهم وعيالاتهم، والشواهد على ذلك كثيرةٌ جدّاً، فخذ مثلاً موقف الغالبيّة يوم الأحزاب، حيث يقول تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} [الأحزاب: 12 – 13]، وكذا موقفهم عند فتح خيبر حيث كان كبار الصحابة ينهزمون ويجبّن بعضهم بعضاً، كما ذكرت ذلك الأحاديث الصحيحة لدى الفريقين في حقّ أبي بكر وعمر وغيرهما [ينظر: المستدرك ج3 ص38، مجمع الزوائد ج9 ص124]، ودونك موقفهم في غزوة تبوك لمّا خرج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لجهاد الروم، فتخلّف أولئك عنه ليستمتعوا بالنساء والطعام والشراب، في حين شكّك أغلب الذين خرجوا معه بنبوّته وهمّوا أن يتركوه في الطريق ويرجعوا إلى أهليهم فكاد الله يزيغ قلوبهم لولا تدارك النبيّ للموقف في اللحظات الأخيرة! [ينظر جوابٌ سابقٌ لمركزنا بعنوان: الحكمة من توبة الله على النبيّ (ص)].
بل من المسلمين مَن خان الله ورسوله من دون جهادٍ أو قتالٍ، كما في قصّة أبي لبابة، وغير ذلك الكثير المواقف من السلبيّة، فإذا كان هذا حال الصحابة ورموز الأمّة في حياة النبيّ (صلّى الله عليه وآله)!، فما بالك بهم وبغيرهم بعد وفاته؟! على أنّ هذه المواقف تكرّرت بذاتها مع أمير المؤمنين وولده الحسن (عليهما السلام) [ينظر: نهج البلاغة خ27، شرح نهج البلاغة ج16 ص38]، حتّى تخاذل الكثير من الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين (عليه السلام) ولم ينصره إلّا نيّف وسبعون نفراً.
من هنا نعلم جيّداً أنّ الأمّة كانت بحاجةٍ إلى صعقةٍ شديدةٍ توقظ ضمائر أبنائها، وتعالج مرض النفاق الذي مردت عليه الشريحة العظمى منهم، وتجعلها تستفيق من سباتها العميق وتتراجع عن اتّباع خطوات الشيطان وحزبه الأمويّ، فتُصبح بذلك مستعدّةً للتضحية بالنفس والعيال والمال في سبيل الله، ومن أجل نيل كرامتها وحرّيتها، فليست نفوس أبناء الأمّة بأعظم من نفس الحسين ونفوس النخبة من أشراف الأمّة الذين استُشهدوا معه (عليه وعليهم السلام)، ولا عيالاتهم بأشرف من خَفِرات الوحي وعقائل النبوّة، وإذن: فالحسين (عليه السلام) بعث الحياة في الأمّة من جديدٍ من خلال التضحية بكلّ شيءٍ حتّى العيال والاطفال، الأمر الذي أثمر عن توالي سبع ثوراتٍ قام بها المسلمون من بعد واقعة الطفّ حتّى أسقطت آخرها دولة بني أميّة [ينظر: الأئمّة الاثنا عشر ص138].
العامل الثاني: معالجة قسوة القلوب التي ضربت الأمّة:
فقد ابتُليت الأمّة بأعظم الأمراض النفسيّة ألا وهو قسوة القلوب، كما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «إنّ لله عقوباتٍ في القلوب والأبدان: ضنكٌ في المعيشة ووهنٌ في العبادة. وما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب» [تحف العقول ص296]، ويشهد لهذا البلاء أنواع الجرائم التي ارتكبها حكّام الجور وأزلامهم ضدّ المستضعفين من المسلمين، كما في الاعتداء على بيت فاطمة (عليها السلام) وكسر ضلعها وإسقاط جنينها، وقيام معاوية بقتل الكثير من الشخصيّات الصالحة وترويع عيالها كما فعل مع آمنة بنت الشريد زوجة الصحابيّ عمرو بن الحمق الخزاعيّ حينما قتل زوجها ورمى برأسه في حجرها وهي في السجن، ونظيره ما فعله بسر بن أبي أرطاة قائد جيش معاوية بن أبي سفيان من حرق للبيوت على أهلها، وسبي النساء المسلمات وبيعهن في الأسواق، وذبح للأطفالٍ الصغار بالسكّين أمام أنظار أمّهاتهم حتّى الهاشميّين منهم كما حصل لولدَي عبيد الله بن العبّاس.
فعمل الحسين (عليه السلام) على تضمين نهضته المباركة للجنبة العاطفيّة والقيم الإنسانيّة ونداء الفطرة السليمة؛ لذا تجد نهضته المباركة لا تزال مؤثرةً في النفوس والضمائر على مرّ التأريخ وبشكلٍ واضحٍ يميّزها عن سائر المعارك والثورات التي حصلت في تاريخ الإنسانيّة رغم كثرتها؛ إذ من المحال أنْ تجد واحدةً من تلك المعارك والثورات استطاعت أن تُناغم الضمير الإنسانيّ بالشكل الذي ناغمته نهضة الحسين (عليه السلام). يقول المؤرّخ الانجليزي إدوارد جيبون: (إنّ مأساة الحسين المروّعة بالرغم من تقادم عهدها وتباين موطنها، لابدّ أن تثير العطف والحنان في نفس أقلّ القرّاء إحساساً وأقساهم قلباً) [مختصر تاريخ العرب ص74]؛ ومن هنا كانت نتيجة هذا التناغم أن يتبرّأ أصحاب الضمائر الحيّة من جرائم بني أميّة ضد عقائل النبوّة وأطفال أهل البيت (عليهم السلام) بوصفها وصمة عارٍ في جبين البشريّة فلابدّ وأن يأتي اليوم الذي تتطهّر منها.
هذه بعض وجوه الحكمة التي تقف وراء اصطحاب الإمام الحسين (عليه السلام) لعياله إبّان نهضته المقدّسة، وبها نكتفي، والحمد لله ربّ العالمين.
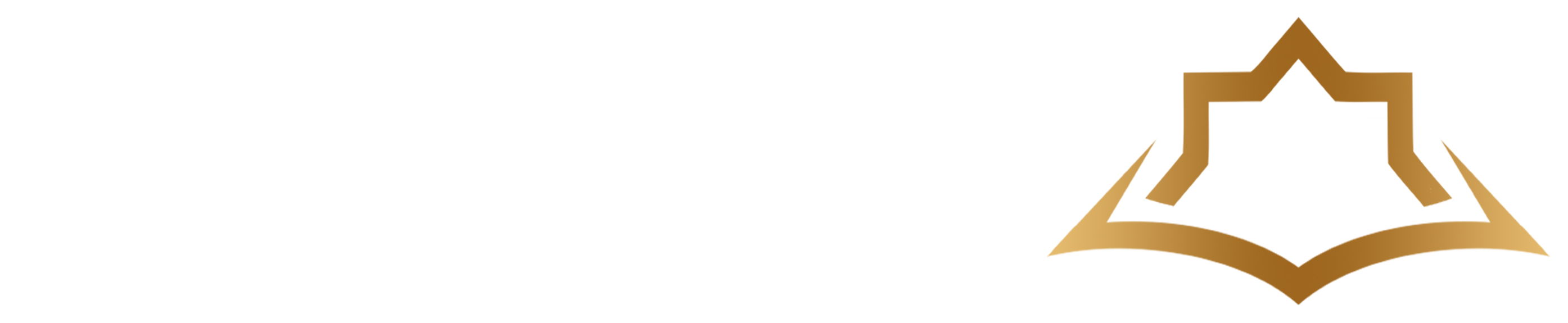


اترك تعليق