«فأبدله الله - عزَّ وجلَّ - بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة»
السؤال: ورَد في مقام أبي الفضل العباس وجعفر بن أبي طالب (عليهما السلام) أنّ ﷲ خلق لكلٍّ منهما أجنحةً يطيرانِ بها في الجنّة. والسؤال هنا: هل هذا الإعطاء في مقام الجزاء والثواب؟ أم من مقامات الاصطفاء؟ وإنْ كان اصطفاءً فما أهيمته؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أخي السائل الكريم، أنّ ما أعطاه الله تعالى للشهيدين العظيمين: مولانا أبي الفضل العباس، ومولانا جعفر بن أبي طالب (عليهما السلام) ليس نوعاً من الجزاء والثواب، كما أنّه ليس من الاصطفاء الابتدائيّ كما سنبيّنُ لك ذلك من خلال عقد الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في بيان أنحاء العطاء الإلهي يوم القيامة، وقد ذكر العلماء أنّها ثلاثة:
الأوّل: ما يسمّى بالأجر، أو فقل: الجزاء والثواب، وقد عرّفوه بأنّه: (النفع المستحقُّ المقارن للتعظيم والإجلال، والذي يستحيل الابتداء به فلا يقع إلّا بتوسّط التكليف فيه) [الباب الحادي عشر ص86]، والمعنى: أنّ العقل يحكم بتوقّف الأجر على عملٍ يكون الإنسان مكلّفاً به، فلا يكون مُستحِقّاً للأجر إلّا بذلك، أو فقل: لا يصدق مفهوم الأجر على الإعطاء بلا عمل يقابله [ينظر تفسير التبيان ج2 ص234]؛ ولذا قال تعالى: { وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [آل عمران: 133-136]، فالآيات صريحةٌ في ارتباط الأجر بالأعمال الصالحة المذكورة فيها.
الثاني: التفضّل، ويُراد به: (النفعُ غيرُ المستحقّ، الواقعُ ابتداءً على جهة الإحسان فلا يستتبع تعظيماً وتبجيلاً) [ينظر: رسائل المرتضى ج2 ص266، تفسير التبيان ج3 ص13]، فهذا النوع من العطاء يأتي ابتداءً ومن دون استحقاق، أيْ: يقع بلا مقابل، وفي الدعاء: «يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها»، فالله سبحانه وتعالى قديم الإحسان والتفضّل والإنعام على عباده من دون استحقاقٍ منهم، ومن اللَّائق بشأنه أنْ لا ينقطع عن ذلك الإحسان والتفضّل على بعض عباده في الآخرة؛ ولذا قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ..} [النساء: 173]، وهذا المعنى واضحٌ في حياتنا اليوميّة، فإنّك لو استأجرت عاملاً لبناء دارك بألف دينار فلمّا بناها أعجبتك فأعطيته أَلفين، فإنّ الألف الأوّل حقّه الذي يستحقُهُ ويمكن له أنْ يطالبك به، وأمّا الثاني فهو إحسانٌ وتفضلٌ منك، فلا يحقُّ له المطالبة به لو منعته.
الثالث: العِوَض، وقد عرّفه علم الهدى المرتضى بقوله: (العوض: النفع المستحقّ المقابل للمضارّ بلا تعظيم) [الرسائل ج2 ص278]، والمعنى: أنّ الله سبحانه وتعالى قد يَبتلي الإنسانَ بحصول الآلام والنقص المادّيّ أو المعنويّ خلال الحياة الدنيا، فاللَّازم - والحال هذه - أن يعوّضه عن ذلك ويجبر ما فَوَّتَه عليه من المنافع في الدنيا بنفعٍ آخر في الآخرة، فَمَن أمره بالجهاد فابتلاه بفقدان كلتا يديه فإنّه فاتته منافع كثيرة؛ من أهمّها فقدانه القدرةَ على الدفاع عن نفسه الشريفة وعن مولانا الحسين (عليه السلام)، وحينئذٍ فاللازم على الله تعالى واللَّائق بجلال قدسه أنْ يقوم بتعويضه عمّا أصابه جرّاء ذلك الابتلاء، ومن مصاديق العوض التي ذكرها الشارع المقدّس للمؤمنين الصالحين هو أنْ لا ينشر له ديواناً أو يقيمهم للمحاسبة، وإنّما يدخلون الجنّة بغير حساب، فبعد أنْ بشّر سبحانه الصابرين على الابتلاء بقوله عزّ وجلّ: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155] عاد فذكر نوعَ ما بشّرهم به بقوله تعالى:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، وفي هذا السياق ورد عن أبي بصير قال: «قلتُ يوماً للباقر: أنتم ورثة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟ قال: نعم، قلتُ: ورسول الله وارث الأنبياء جميعهم؟ قال: وارث جميع علومهم. قلتُ: وأنتم ورثتم جميع علوم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟ قال: نعم، قلتُ: فأنتم تقدرون أن تُحيوا الموتى وتُبرئوا الأكمه والأبرص وتُخبروا الناس بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم؟، قال: نعم، نفعل ذلك بإذن الله تعالى، ثمّ قال: ادنُ منّي يا أبا بصير - وكان أبو بصير مكفوفَ النظر- قال: فدنوتُ منه فمسح بيده على وجهي، فأبصرتُ السماء والجبل والأرض، فقال: أتحبُّ أن تكون هكذا تبصر، وحسابُك على الله؟ أو أن تكون كما كنت ولك الجنّة؟! قلت: الجنّة، فمسح بيده على وجهي فعدت كما كنت» [نور الأبصار ص294، الكافي ج1 ص470]، وكما ترى فالخبر صريحٌ في أنّه لو اختار البصر لكان ممّن يحاسبهم الله تعالى، بخلاف ما لو صبر على نقصانه فإنّ له الجنّةَ خالصةً بغير حساب.
فإذا اتّضح لك جميع ذلك، فاعلم أنّ نَيْل أبي الفضل العبّاس وجعفر الطيار (عليهم السلام) الجناحين، أعلى من كونه أجراً مترتّباً على امتثال تكليف الجهاد، وأرفع من أنْ يقف عند مجرّد الشهادة، كما أنّه أقدس من أن يكون تفضّلاً عامّاً مثل الذي لكلّ الخلائق؛ ضرورة أنّ أجر شهادة العبّاس هو الجنّة، مع أنّه (صلوات الله عليه) نال ما هو أعظم منها، وهذا يكشف عن أنّ نيل الجناحين عطاءٌ من نوعٍ آخر، لا يمكن تحقّقه إلّا بالمجموع، فلم يبقَ حينئذٍ إلّا أن يكون جعل الأجنحة هو نوع عِوَضٍ من الله تعالى لهما (عليهما السلام) بدلاً عن أيديهما الطاهرة، أي هو جبرٌ منه تعالى لهما عمّا ابتلاهما به من النقص والأذىً الذي لحق بهما بسبب جهادهما في سبيله، وتعويضٌ لهما عن الضرر الذي وقع عليهما جرّاء نصرتهما لدينه.
والدليل على ذلك رواية الإمام زين العابدين(عليه السلام) نفسها التي نَصّت على جعل الجناحين لأبي الفضل (عليه السلام)، فقد روى الصدوق عنه (عليه السلام) أنّه قال: «رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله الله عزّ وجلّ بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلةً يغبطُهُ بها جميع الشهداء يوم القيامة» [الخصال ص86]، وكما هو واضحٌ فإنّ قوله (عليه السلام): « فأبدله » يعني: (عَوَّضَهُ)، قال أبو هلال العسكري: (والعوض: هو البدل الذي يُنتفع به كائناً ما كان) [الفروق اللغويّة ص381]. ومن ذلك يُعلم أنّ هذا التعويض هو شيء خارجٌ عمّا يستحقّانه (عليهما السلام) من الأجر والثواب الذي لا يعلم نوعه ومقداره إلّا الله تعالى.
وأمّا أهميّة جعل هذين الجناحين لهما (عليهما السلام) فتظهر من خلال: ما صرّح به أمير المؤمنين(عليه السلام) في إحدى رسائله إلى معاوية بن أبي سفيان من أنّ التعويض بالجناحين أمر خاصّ بشهداء أهل البيت (عليهم السلام) دون سائر شهداء الأمّة كلّهم حتّى وإن قُطّعت أيديهم، حيث يقول: «ألا ترى غيرَ مخبرٍ لك ولكن بنعمة الله أُحدِّثُ أنّ قوماً استشهدوا في سبيل الله تعالى من المهاجرين والأنصار – ولكلٍّ فضلٌ – حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيّد الشهداء، وخصّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه.. أو لا ترى أنّ قوماً قُطِّعت أيديهم في سبيل الله – ولكلٍّ فضلٌ – حتّى إذا فُعل بواحدنا ما فُعل بواحدهم قيل: الطيّار في الجنّة وذو الجناحين» [نهج البلاغة ص386].
ويرجع السرّ في تميّزهم عن الآخرين في هكذا عوضٍ فريدٍ إلى اختلاف أهل البيت (عليهم السلام) من جهة كونهم أكمل وأعظم وأفضل الأفراد في الأمّة على الإطلاق، ومن الواضح أنّ شرط العوض كونه مساوياً للمعوَّض بنحو يستوفي من خلاله الإنسان حقّه كاملاً، فلابدّ أنْ يكون عوض أبي الفضل العباس وجعفر الطيّار(عليهما السلام) موازياً لمكانتهما وشأنهما اللائق بهما فإنّهما من أهل بيتٍ لا يقاس بهم أحد من الأمّة، ولا تقاس أيدي أحد منها بأيديهم الطاهرة المقدّسة، كما روى ذلك أنس بن مالك عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: «نحن أهلُ بيتٍ لا يقاسُ بنا أحدٌ» [كنز العمال ج12 ص104]، فتدبّر جيّداً.
الجهة الثانية: في بيان عدم ارتباط موضوع الجناحين بالاصطفاء:
عرفت ممّا تقدّم: أنّ جعل الأجنحة هو نوع عوضٍ خاصٍّ لأبي الفضل العباس وجعفر الطيّار (عليهما السلام) لائق بمكانتهما وشأنهما، وليس أجراً لهما؛ فإنّ أجرهما أعظم، ومنه يتّضح ليس نوعاً من أنواع الجزاء المترتب على التكليف فقط، ولا أنّه من قبيل التفضّل العام؛ كالرحمة العامّة المفاضة على قاطبة الخلائق مؤمنهم وكافرهم، وأيضاً ليس هو من جنس العوض العام، وإنّما هو عوضٌ خاصٌّ؛ كما أنّه ليس من جنس الاصطفاء الابتدائيّ اللّدنيّ الخاصّ بالمعصومين أنبياء وأوصياء وملائكة، ولا ينافيه أنْ يكون اصطفاء كسبيّاً مترتّباً على أقصى الطاعات وأشرف خلوص النياَّت، ويظهر ذلك من معانيه فإنّ للاصطفاء معنيين:
أحدهما: هو أخذ صفوة الشيء وتمييزه عن غيره إذا اختلطا، فيكون بمعنى انتخاب واختيار شيء من بين أشياء [ينظر مجمع البيان ج1 ص395]، فلو كانت لدينا مجموعة أشياء متشابهة مشتركة في بعض الخصائص والصفات، فقمنا باختيار أحدها وتصفيته ممّا يشوبه لتمييزه عنها، فإنّ مثل هذه العمليّة تُسمّى: (اصطفاء الشيء من الأشياء).
والآخر: بمعنى التفضيل والتقديم لشيء على بقية الأشياء في خصوصيّة خاصّة لا تشاركه فيها تلك الأشياء، فيكون بمعنى اختيار شيء على الأشياء، لا من الأشياء، كما جاء في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران: 33 -34].
والذي يدلّنا على المعنيين معاً: هو قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 42]، حيث ورد فيه اصطفاءان، وأحدهما جزماً غير الثاني، فإنّ الأوّل يعني الاختيار والانتخاب، والثاني يعني التفضيل والتقديم على نساء عالمها [يُنظر: تفسير الميزان ج3 ص300، تفسير الرازي ج8 ص45]. وهو كما ترى فإنّه بكلا المعنيين حاصلٌ ابتداءً وعلى نحو التفضّل منه تعالى لما يراه من شأنيّة مريم (عليها السلام) للمعنيين معاً، وهذا ما ينافي بدوره العوض الذي لا يكون ابتداءً وإنّما يكون مترتّباً على فقدان شيءٍ وتعويضه بآخر غيره.
نعم، يمكن استفادة الاصطفاء بالمعنى الثاني بالنسبة إلى خصوص مولانا أبي الفضل العباس (عليه السلام)، لكنْ.. لا من جهة استبداله يديه الطاهرتين بجناحين، بل من جهاتٍ أخرى: مثل اختياره وزيراً للحسين (عليه السلام) كما اختار الله أباه أمير المؤمنين (عليه السلام) وزيراً لرسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأيضاً مثل المنزلة التي ذكرتها الرواية المتقدّمة للإمام زين العابدين (عليه السلام) أعني قوله: «وإنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلةً يغبطُهُ بها جميع الشهداء يوم القيامة»، فإنّ هذه المنزلة لا يتشارك أحدٌ من الشهداء فيها مع أبي الفضل (عليه السلام)؛ ولذلك هم جميعاً يغبطونه بها ويتمنون حصول مثلها لهم، ولو أنّ واحداً منهم شاركه فيها لما قال (عليه السلام): «جميع الشهداء» فإنّه دالّ على العموم والشمول، فتدبّر جيّداً.
والجدير بالذكر أنّ مجيء الإمام (عليه السلام) بمفردة «منزلة» على نحو التنكير، وسكوته عن بيان نوعها وحقيقتها، يُشعر بعظمتها بنحوٍ لا يريد معه وصفها، أو لأنّها منزلة لا يعلم نوعها وحقيقتها إلّا الله تعالى، فتكون من قبيل قوله تعالى في أجر المؤمنين المتّقين: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[السجدة: 17]؛ وإلّا فلو لم تكن هذه المنزلة عظيمةً في نوعها وحجمها لما كانت موجبةً للغبطة، الأمر الذي يكشف عن أنّ التعويض بالجناحين شيءٌ وأجره (عليه السلام) شيءٌ آخر!.
هذا.. وقد وردت بعض الروايات التي تفيد وجود منزلة خاصّة لكفَّي مولانا أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يوم القيامة حيث إنّهما من أعظم وسائل الشفاعة إلى الله تعالى هناك، فقد نقل الشيخ الكلباسيّ أنّه: «إذا كان يوم القيامة واشتدّ الأمر على الناس، بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - بإذنٍ من الله تعالى - الإمامَ أميرَ المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنته الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) لِتحضرَ مقام الشفاعة. فيُقبل الإمامُ أمير المؤمنين (عليه السلام) إليها ويخبرها بما قاله أبوها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ويطلب منها حضور مقام الشفاعة، ثمّ يسألها قائلاً: يا فاطمة، ما عندك من أسباب الشفاعة؟ وما الذي ادّخرتيه لأجل هذا اليوم الذي فيه الفزع الأكبر. فتجيبه فاطمة (عليها السلام) بقولها له: يا أمير المؤمنين، كفانا لأجل هذا المقام اليدان المقطوعتان مِن ابنيَ العبّاس!» [الخصائص العبّاسيّة ص325].
وكيفما كان، فخلاصة القول: أنّ نيل الجناحين عوضٌ خاصٌّ وليس عامّاً؛ ضرورة أنّه لا يعمّ كلّ الشهداء الكُمَّل ممّن فقدوا أعضائهم في الجهاد كبقية شهداء كربلاء مثلاً؛ لاختصاصه بعد المعصومين (عليهم السلام) بمن حاز على أعلى مراتب الشهادة وأكملها؛ وذلك لترتّب العوض عند خصوص العبّاس، على مجموع أمور طوليّة هي كالآتي:
أولاً: أعلى مراتب الطاعة والتسليم قلباً، قياساً بمرتبة بقيّة شهداء كربلاء العالية.
ثانياً: أعلى مراتب امتثال تكليف الجهاد، قياساً ببقيّة شهداء كربلاء مثلاً.
ثالثاً: أعلى مراتب الشهادة، وبالتالي أعلى مراتب الأجر، قياساً ببقيّة شهداء كربلاء مثلاً.
رابعاً: أعلى مراتب العوض، قياساً ببقيّة شهداء كربلاء مثلاً؛ لترتبه على الثلاثة أعلاه.
ختاماً هذا ما وفّقنا الله تعالى لتحريره في المقام، والحمد لله ربّ العالمين.
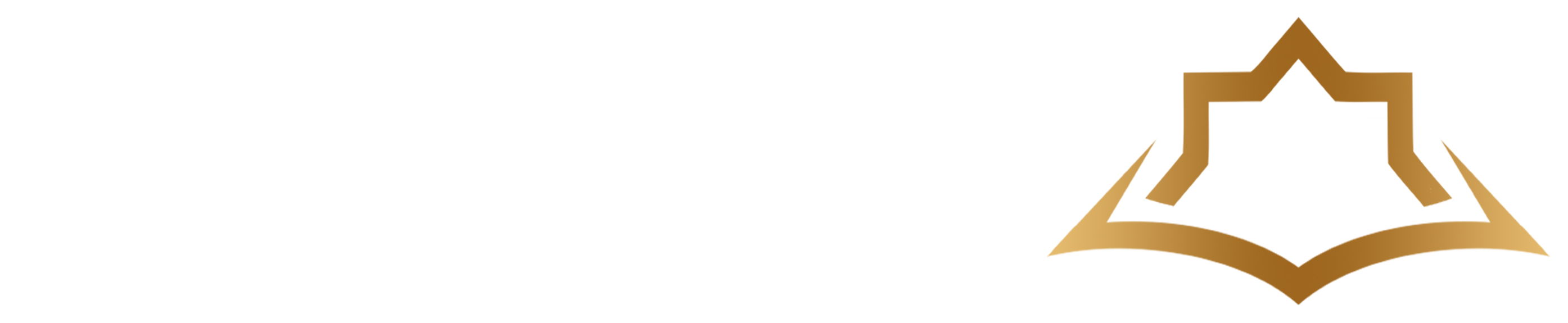


اترك تعليق