الإمام الباقر (ع) والتأسيس لنظام المرجعيّة
ما هي الخطوات العمليّة التي قام بها الإمام الباقر (عليه السلام) في مشروع التأسيس لنظام المرجعيّة؟ وكيف فعل ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
يحسن بنا قبل بيان الخطوات العمليّة لمشروع التأسيس لنظام المرجعيّة أنْ نذكر توطئةً مهمّةً، فإنّ الأحداث التي تلت وفاة النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وكذا المشكلات السياسيّة والأمنيّة التي واجهها الأئمة السابقون على الإمام الباقر (عليه وعليهم السلام) كانت قد تركت فراغاً فقهيّاً كبيراً في حياة الأمّة بشكلٍ عام، ولا سيّما عند أتباع التشيّع الذين دفعت بهم تقيّة الإرهاب الأمويّ إلى أخذ أحكامهم الشرعيّة من الإمام السجّاد (عليه السلام) عن طريق مولاتنا زينب الحوراء (عليها السلام) [ينظر: كمال الدين ص501]، فكان الشيعة بحاجة ماسّة إلى حلقات وصلٍ بينهم وبين أئمّتهم (عليهم السلام) يتعرّفون عن طريقها إلى أمور دينهم ويتفقّهون في أحكام الشريعة.
وبمجرّد أنْ تولّى الإمام الباقر (عليه السلام) منصب الإمامة، اتّجه نحو التأسيس لنظام المرجعيّة الدينيّة؛ لكي يوفّر احتياج شيعته، ويفتح لهم فتحاً مبيناً، وينقذهم من حيرتهم، ويغنيهم عن فقهاء السوء وأئمّة الضلال. جاء في صحيحة أبي اليسع عيسى بن السريّ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «ثمّ كان محمّد بن علي أبو جعفر، وكانت الشيعة قبل أنْ يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم، حتّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبَيَّن لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حتّى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس» [الكافي ج2 ص20]، وقد تمثّلت مسيرة هذا المشروع بعدّة خطوات قام بها الإمام (عليه السلام) نذكر لك أبرزها:
الخطوة الأولى: انتخاب الشخصيّات الصالحة للفقاهة والزعامة الدينيّة:
لقد تمثّلت باكورة أعماله (عليه السلام) باصطفاء جماعةٍ صالحةٍ من أصحابه وخواصّه ليعمل على تربيتهم كعلماء ربّانيّين، وإعدادهم كفقهاء صالحين، وأمناء على علوم الوحي والرسالة، فكان من بينهم: زرارة بن أعين، أبان بن تغلب، محمّد بن مسلم، ليث بن البختري، أبو حمزة الثمالي، أبو بصير الأسديّ، الفضيل بن يسار، بكير بن أعين، حمران بن أعين، بُريد بن معاوية العجلي، وغيرهم، وقد ذكر العلّامة الشيخ القرشيُّ تراجم (482) شخصيّةً من أصحابه (عليه السلام) الذين تتلمذوا على يده ونهلوا من غزير علومه[ينظر: حياة الإمام الباقر ج2 ص189].
وقد أثنى أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) على أبرز شخصيّات هذه الصفوة، فمن ذلك ما رواه الشيخ المفيد بإسناده عن سليمان بن خالد الأقطع قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديثَ أبي (عليه السلام) إلّا زرارة وأبو بصير المراديّ ومحمد بن مسلم وبُريد بن معاوية، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدىً، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي (عليه السلام) على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا وفي الآخرة» [الاختصاص ص66]، وكذلك انعقد إجماع علماء الطائفة (أعلى الله برهانهم) على الشهادة لهؤلاء الأجلّة بالفقه والوثاقة، قال الكشيّ: (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبُريد، وأبو بصير الأسديّ، والفُضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم الطائفيّ، قالوا: وأفقه الستّة زرارة، وقال بعضهم -مكان أبي بصير الأسديّ-: أبو بصير المراديّ، وهو ليث بن البختريّ) [رجال الكشّي ج2 ص507].
الخطوة الثانية: تأسيس جامعة أهل البيت (عليهم السلام):
بدأت الحركة العلميّة للإمام (عليه السلام) عن طريق تأسيس جامعة أهل البيت (عليهم السلام) للعلوم الشرعيّة، وكانت في أوائل ظهورها تتشكّل على هيئة حلقات دراسيّة يعقدها الإمام (عليه السلام) في بيته الذي كان مقصداً لطلّاب العلوم ومتعطّشي المعرفة، ثمّ ما برحت تلك الحلقات أنْ انتقلت إلى المسجد النبويّ الشريف لتّتسع وتستقطب المئات من علماء العامّة والخاصّة، قال السيّد هاشم معروف الحسنيُّ: (لا أحسب أحداً بريئاً من مرض الجهل والتعصب يتّهمني بالغلو أو التحيّز إذا أعطيت لتلك الحلقات التي كانت تجتمع في مسجد المدينة إلى الإمام أبي جعفر الباقر بالذات، اسم الجامعة، لأنّها كانت تجمع بين الحين والآخر المئات من مختلف الأقطار لدراسة الفقه والحديث والفلسفة والتفسير واللغة وغير ذلك من مختلف العلوم...) [سيرة الأئمّة الاثني عشر ج2 ص201].
الخطوة الثالثة: نشر العلوم الدخيلة في عمليّة الاستنباط:
لم تكن جامعة أهل البيت (عليهم السلام) مجرد مؤسّسة تسعى لتعليم طلّابها أحكام الشريعة، بل هي أرفع من ذلك بكثير، حيث عمل الإمام (عليه السلام) على تعليم أصحابه أصول الاستنباط وكيفيّة استخراج الأحكام الشرعيّة من مداركها المقرّرة كالقرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة بشكلٍ صحيح، بعيداً عمّا شاع آنذاك من لجوء علماء العامّة إلى العمل بالقياس والاستحسان والرأي وإنْ استلزم الأمر مخالفتهم النصوص الشرعيّة، ثمّ أوردهم غدير معارفه وما يحتاجون إليه من أصناف العلوم والمعارف والفنون التي تدخل بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر في عمليّة الاستنباط، فكان من ذلك:
1ـ علم التفسير:
إذ عقد الإمام (عليه السلام) الكثير من حلقات التفسير لآيات الذكر الحكيم، وكيفيّة الاستدلال بها على الأحكام الشرعيّة وناقشه فيها تلامذته بحريّةٍ تامّة، فمن شواهد ذلك مثلاً ما في صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أَلا تخبرني من أين علِمتَ وقُلتَ: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثمّ قال: يا زرارة، قاله رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أنْ يُغسل ثمّ قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، ثمّ فَصَلَ بين الكلامين فقال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} فعرفنا حين قال {بِرُءُوسِكُمْ} أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وَصَلَ الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها.. الخبر» [الكافي ج3 ص30].
2- علم الحديث:
حيث أكثر (عليه السلام) من الأحاديث المرتبطة بالأحكام الشرعيّة في مختلف أبواب الفقه، ويشهد له بذلك: أنّ الأغلب الأعمّ من أحاديث الكتب الأربعة والموسوعات الحديثيّة كانت ترجع إليه وإلى ولده الصادق (عليهما السلام)، ولم يكن ذلك مقتصراً على شيعته وأصحابه، بل قد أتاح معرفة أحكام الله تعالى لجميع علماء المذاهب باعترافهم، قال ابن كثير في ترجمته (عليه السلام): (وحدّث عنه جماعةٌ من كبار التابعين وغيرهم، فممّن روى عنه ابنه جعفر الصادق، والحكم بن عتيبة، وربيعة، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعيّ، والأوزاعيّ والأعرج، وهو أَسنُّ منه، وابن جريج، وعطاء، وعمرو بن دينار، والزهريّ. وقال سفيان بن عُيينة عن جعفر الصادق قال: حدّثني أبي وكان خير محمديٍّ يومئذٍ على وجه الأرض، وقال العجليّ: هو مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث..) [البداية والنهاية ج9 ص338].
3ـ علم أصول الفقه:
وهو العلم بالقواعد العامّة التي تتوقّف عليها عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة ويحتاج إليها الفقيه في جميع أبواب الفقه بلا استثناء، فإنّه بواسطة هذا العلم يمكن معرفة ما هو الدليل على الحكم الشرعيّ ممّا ليس بدليل عليه؛ ولهذا لا يكون الفقيه فقيهاً ومجتهداً من دون الإحاطة التامّة بمسائل هذا العلم، قال الآخوند الخراسانيّ (قُدّس سرّه): (لا محيص لأحدٍ في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلتها إلّا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصوليَّة، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباطٍ واجتهاد) [كفاية الأصول ص468]، ولم يكن أحد من المسلمين جميعاً يعرف عن هذا العلم شيئاً، ولا سمع به من قبل حتّى جاء الإمام الباقر (عليه السلام) فأظهره لهم فصار الشيعة روّاد علم الأصول بلا منازع منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، قال السيّد حسن الصدر: (فاعلم أنَّ أوّل من فتح بابه وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر، وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق، وقد أمليا فيه على جماعةٍ من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتّبها المتأخرون على ترتيب مباحثه ككتاب «أصول آل الرسول» وكتاب «الفصول المهمة في أصول الأئمة» وكتاب «الأصول الأصلية» كلّها بروايات الثقات مسندةٍ متّصلة الإسناد إلى أهل البيت عليهم السلام) [الشيعة وفنون الإسلام ص78]، فمن تلك القواعد والمسائل الأصوليّة التي جاءت عنه (عليه السلام) مثلاً: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعلاج التعارض والتراجيح، وقاعدة الاستصحاب، ومن شواهد ذلك ما في صحيحة زرارة عنه (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلتُ فإنْ حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بَيِّنٌ وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقينٍ آخر» [التهذيب ج1 ص8].
4- العلم بالقواعد الفقهيّة:
وهي مجموعة قواعد كلّية خاصّة تساعد في التوصّل للحكم الشرعيّ وتدخل في الكثير من أبواب الفقه، فمنها ما يختصّ بأبواب المكاسب كالتجارة والإجارة ونحوهما كقاعدة السلطنة مثلاً، ومنها ما يختصّ بالعبادات كقاعدة الحلّ وغير ذلك، ومن شواهده مثلاً تنصيصه على قاعدة الفراغ التي تختص بكتاب الصلاة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: «كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتِك فأَمضِ ولا تُعِد» [تهذيب الأحكام ج2 ص352] حيث استفاد الفقهاء منها الحكم بعدم الاعتناء بمختلف أنواع الشكّ في أفعال الصلاة بعد الفراغ منها.
5- علم الرجال:
فإنّ من أبرز أدوات الفقيه في عمليّة الاستنباط الوقوف على أسانيد الأحاديث ورواتها؛ بعدما طغت على المشهد السياسيّ والطائفيّ ظاهرة وضع الأحاديث المكذوبة؛ فلذا كان (عليه السلام) يرشد طلّابه إلى أهميّة الوقوف على الأسانيد في قبول الأحاديث والعمل بها، حتّى أنّه (عليه السلام) يقول: «إذا حَدّثتُ الحديث فلم أُسنده فسندي فيه أبي عن جدّي عن أبيه عن جدّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عزّ وجلّ» [الإرشاد ج2 ص167] فمع أنّ الإمام (عليه السلام) غنيٌّ عن الحاجة إلى إسناد أحاديثه؛ لمكان وراثته لعلوم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلوم جميع الأنبياء (عليهم السلام)، كما أنّ صدقه والتصديق به لا يتوقفان على إسناد ما يقوله؛ لمكان عصمته، إلّا أنّنا نجده (عليه السلام) يذكر سند أحاديثه هنا، تلميحاً منه إلى ضرورة العناية بمعرفة الأسانيد والاهتمام بعلم التراجم والرجال؛ لما يشكّله ذلك من أهميّةٍ بالنسبة للفقيه في عمليّة الاستنباط كما لا يخفى.
الخطوة الرابعة: توزيع الفقهاء في الأمصار والعناية بهم:
بعد أن بلغ هؤلاء الصفوة حدود النظر والاجتهاد وحازوا القدرة على الاستنباط سارع الإمام (عليه السلام) إلى توزيعهم في المدائن والبلدان، وحثّهم على التصدّي للإفتاء طبقاً لعلوم آل محمد (صلّى الله عليه وآله)، كما في قوله لأبان بن تَغلب: «اجلس في مسجد المدينة وأَفتِ الناس، فإنّي أحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك» [فهرست الطوسيّ ص57]، وكان لا يقطع يد العناية بهم ومساعدتهم، فكلّما أشكلت عليهم مسألة سألوه عن حكمها ومدركها أبان لهم ذلك، وكشف لهم عن حكمها وأوضح مدركها، فأصبح لكلّ فقيهٍ منهم أتباعٌ ومقلّدون تحسبهم لكثرتهم فرقة مستقلّةً من الفرق الإسلاميّة وليسوا كذلك، حتّى أنّ السلطة العباسيّة قد طلبت من بعض عمّالها كتابة تقرير استخباريّ للخليفة عن الأوضاع الدينيّة، فكتب لهم ابن المقعد كتاباً صنّف فيه صنوف الفرق فكان ممّا جاء في كتابه: (وفرقة منهم يقال لهم الزُراريّة [أي أتباع زُرارة بن أعين]، وفرقة منهم يقال لهم العَمّاريَّة - أصحاب عمّار الساباطيّ -، وفرقة يقال لها اليعفوريّة - أي أتباع عبد الله بن أبي يعفور -، ومنهم فرقة أصحاب سليمان الأقطع، وفرقة يقال لها الجواليقيّة [وهم أتباع هشام بن سالم الجواليقيّ]) [رجال الكشي ج2 ص542].
وهكذا مكّن الله تعالى للإمام (عليه السلام) تأسيس نظام المرجعيّة الدينيّة منذ ذلك الوقت، ليبقى قائماً إلى عصرنا الراهن، حيث أصبح المذهب اليوم يزخر بوجود المئات من مراجع الدين الربّانيين الذين حفظوا علوم أهل البيت (عليهم السلام) من الاندراس والضياع، وتوزّعوا في ارجاء المعمورة فصانوا للشيعة دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وأغنوهم عن مرجعيّات المذاهب الأخرى.
ختاماً، هذا ما وفّقنا الله تعالى من تحريره في المقام ، والحمد لله ربّ العالمين.
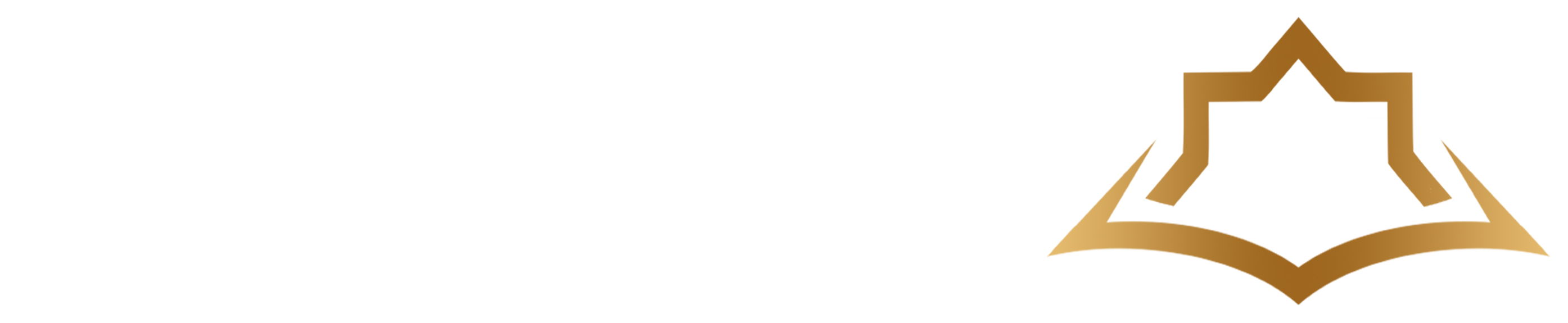


اترك تعليق