دور الإمام الباقر (ع) في تثبيت العقيدة
يذكر بعض الباحثين أنّ الإمام الباقر (عليه السلام) له الدور الأكبر في تثبيت عقيدة المذهب، فما الذي مارسه الإمام الباقر (عليه السلام) حتّى يوصف بأنّه صاحب الدور الأكبر؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
لا شبهة ولا إشكال في أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا جميعاً شركاء في تثبيت العقيدة الإسلاميّة بصورةٍ عامّةٍ بعد رحيل النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) إلى الرفيق الأعلى، وكذلك في تأصيل وترسيخ عقيدة المذهب، وإنّما تختلف المنهجيات والأدوار بحسب مقتضيات المرحلة التي يعيش فيها كلّ واحدٍ منهم، كما أوضحناه في جواب بعنوان: (مراحل عمل الأئمّة الأطهار). وقد برز دور الإمام الباقر (عليه السلام) من بينهم لتوفر الظروف السياسيَّة والأمنيَّة الملائمة، فأصبح صاحب السهم الأوفر في ذلك، وكان من أبرز ما اتّسم به دوره (عليه السلام) على الصعيد العقائديّ هو العمل على الاتجاهات الآتية:
الاتجاه الأوّل: بيان عقائد المذهب وإخراجها من عالم الثبوت إلى الإثبات:
لقد حرص الإمام (عليه السلام) على بيان العقائد الحقّة للناس، وأبرز لهم أدلّتها والواضحة، وإقام البراهين الجليّة عليها بنحوٍ يجعل من مجموعها كاشفاً عن الهويّة الشيعيّة المستقلّة، فاهتمّ بالتعريف بأصول الدين التي عليها مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بدءاً بالتوحيد وانتهاءً بالمعاد. وكنموذج على ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم عن توحيد الإله ونفي التركيب عنه، وإثبات عينيّة الصفات له تعالى بعد أنْ نفتها بعض المدارس الكلاميّة الأخرى، فقال (عليه السلام) في وصفه تعالى: «إنّه واحدٌ صمدٌ أحديّ المعنى ليس بمعانٍ كثيرةٍ مختلفة، قال: قلتُ: جُعِلتُ فداك، يزعم قومٌ من أهل العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصر، ويبصر بغير الذي يسمع، قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبّهوا، تعالى الله عن ذلك، إنّه سميعٌ بصيرٌ يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، قال: قلت: يزعمون أنّه بصير على ما يعقلونه، قال: فقال: تعالى الله! إنّما يُعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك» [الكافي ج1 ص108].
وهكذا فيما يتعلّق بالمسائل المتفرّعة على تلك الأصول كما في مسائل الإمامة مثلاً، فمن ذلك ما رواه الصدوق بإسناده إلى جابر الجعفيّ قال: «قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) لأي شيء يُحتاج إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والإمام؟ فقال: لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبيٌّ أو إمام، قال الله عزّ وجلّ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}، وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله): النجوم أمانٌ لأهل السماء، وأهل بيتي أمانٌ لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهلَ السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهلُ بيتي أتى أهلَ الأرض ما يكرهون، يعني بأهل بيته الأئمّة الذين قرن الله عزّ وجلّ طاعتهم بطاعته فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، وهم المعصومون المطهّرون الذين لا يذنبون ولا يعصون وهم المؤيَّدون الموفَّقون المسدَّدون ، بهم يرزق الله عباده، وبهم تعمر بلاده، وبهم يُنزل القطر من السماء، وبهم يُخرج بركات الأرض، وبهم يُمهل أهل المعاصي ولا يَعجل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم (صلوات الله عليهم أجمعين)» [علل الشرائع ج1 ص123].
الاتجاه الثاني: التركيز على أهميّة التولّي لأهل البيت (عليهم السلام) والبراءة من عدوّهم، وأنّه لا تديُّن ولا نجاة إلّا بذلك:
أوضح الإمام الباقر (عليه السلام) للناس ضرورة التمسّك بهم بعنوان كونهم الأئمّة الهداة المعصومين، وحجج الله على خلقه، والأدلّاء عليه الذين ليس لهم في الأرض عدل ولا نظير ولا قرين سوى كتاب الله تعالى، وأنّه لا ولاية من دون البراءة من عدوّهم، وله في ذلك أحاديثُ كثيرة، كقوله لأبي الجارود: «والله لأُعطينّك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عزّ وجلّ به، شهادة أنْ لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لوليّنا والبراءة من عدوّنا، والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع» [الكافي ج2 ص22].
كما كان (عليه السلام) يؤكّد على ضرورة التواصل المستمر مع سيّد الشهداء (عليه السلام) والمحافظة على زيارته فإنّ ذلك يُعدّ به من أبرز دعائم الهويّة الشيعيّة ومقوّماتها، كقوله (عليه السلام): «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يُقِرّ للحسين "عليه السلام" بالإمامة من الله عزّ وجلّ» [كامل الزيارات ص236].
وعلى صعيدٍ آخر لم يهمل الإمام أهميّة الارتباط العاطفي لا سيّما بجدّه الحسين (عليه السلام)، فعن صالح بن عقبة عن أبيه عنه (عليه السلام) أنّه قال: «مَن زار الحسين بن عليّ (عليهما السلام) في يوم عاشوراء من المحرم حتّى يظلّ عنده باكياً لقي الله عزّ وجلّ يوم يلقاه بثواب ألفي حَجّة، وألفي عمرة، وألفي غزوة، ثواب كلّ غزوةٍ وحَجّةٍ وعمرةٍ كثواب من حجّ واعتمر وغزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومع الأئمّة الراشدين!
قال: قلتُ: جُعلتُ فداك، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟
قال: إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسلام، واجتهد في الدعاء على قاتله وصلّى من بعد ركعتين، وليكن ذلك في صدر النهار قبل أنْ تزول الشمس، ثمّ لِيندب الحسين (عليه السلام) ويبكيه ويأمر من في داره ممّن لا يتّقيه بالبكاء عليه، ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه، وليعزِّ بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين "عليه السلام" وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله تعالى جميع ذلك، قلت: جعلت فداك أنت الضامن ذلك لهم والزعيم ؟ قال: أنا الضامن وأنا الزعيم لمن فعل ذلك» [مصباح المتهجّد ص722].
بل كان (عليه السلام) يؤكّد على ضرورة بيان مظلوميّتهم جميعاً، وإظهار الحزن عليهم أمام الملأ، ففي صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لِنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى» [الكافي ج5 ص117].
الاتجاه الثالث: مواجهة التيّارات والمذاهب الفكريّة والعقديّة والفلسفيّة المنحرفة:
وتتّضح معالم هذا الاتجاه من خلال تكثيف الإمام (عليه السلام) لجهوده وصبّها في ناحيتين:
الناحية الأولى: السعي الحثيث إلى إصلاح أصحاب تلك التيّارات قدر المستطاع وإعادتهم إلى جادّة الرشد والصواب، فمن ذلك مثلاً كلامه مع الحسن البصريّ القائل بالتفويض، فعن أبي حمزة الثمالي قال: «أتى الحسن البصري أبا جعفر (عليه السلام) فقال: جئتك لا سألك عن أشياء من كتاب الله.
فقال أبو جعفر: ... بلغني عنك أمرٌ فما أدري أكذاك أنت، أم يُكذب عليك؟ قال: ما هو؟ قال: زعموا أنّك تقول: إنّ الله خلق العباد ففوّض إليهم أمورهم؟ قال: فسكت الحسن - فوعظه الإمام ونهاه عن ادّعاء العلم فإنّه ليس أهلاً لذلك، ثمّ قال: - ... وإياك أنْ تقول بالتفويض، فإنّ الله عزّ وجلّ لم يفوّض الأمر إلى خلقه، وهناً منه وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً» [تفسير الثمالي ص237].
الناحية الثانية: نشر الأحاديث التوعويّة الكاشفة عن انحراف هذه التيارات وفساد أطروحاتها على اختلافها، ورفع المستوى المعرفي لدى المسلمين عامّة والشيعة خاصّة من خلال بيان وجوه فساد هذه التيّارات، وإقامة الأدلّة على انحرافها عن المسار الصحيح والصراط القويم، فمن ذلك مثلاً قيامه (عليه السلام) بلعن المرجّئة علناً، والتبري منهم حيث يقول: «اللهمّ العن المرجئة، فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة» [الكافي ج8 ص276]، وكذلك موقفه من الغلاة وقيامه بلعنهم وتحذير شيعته من فكرهم المنحرف، فقال (عليه السلام): «يا معشر الشيعة - شيعة آل محمد- كونوا النمرقة الوسطى، يرجع إليكم الغالي، ويلحق بكم التالي.
فقال له رجلٌ من الأنصار يقال له سعد: جُعِلتُ فداك، ما الغالي؟
قال: قومٌ يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، فليس أولئك منّا ولسنا منهم» [الكافي ج2 ص75].
الاتجاه الرابع: تنقية السنّة النبويّة الشريفة من الموضوعات والإسرائيليّات التي خالطت التراث الفكريّ والروائيّ الإسلاميّ:
فقد واجه الإمام (عليه السلام) هذه الروايات الدخيلة التي كانت تشوب السنّة الشريفة، وبدأت تُلوّث الفكر الإسلاميّ عقيدة وتاريخاً وتفسيراً بعدما نشأت في حاضرة المسلمين على يد كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وأمثالهم من اليهود المتأسلمين، فوقف (عليه السلام) بقوّةٍ أمامها وأنكر على الناس تأثرهم بها وتصديقهم لها، وعمل على بيان كذبها وزيفها، فمن ذلك مثلاً ما رواه الكلينيُّ في الخبر الصحيح، بالإسناد إلى زرارة بن أعين قال: «كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتبٍ مستقبل الكعبة، فقال: أما إنّ النظر إليها عبادة، فجاءه رجلٌ من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ كعب الأحبار كان يقول: إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب!
فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذبتَ وكذب كعب الأحبار معك! وغضب [أي الإمام]، قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً بقول "كذبتَ" غيره، ثمّ قال: ما خلق الله عزّ وجلّ بقعة في الأرض أحبّ إليه منها.
ثمّ أومأ بيده نحو الكعبة: ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها، لها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض...» [الكافي ج4 ص240]، وهنالك الكثير من الشواهد الأخرى المتعلّقة بالتفسير أو الحقائق التاريخيّة.
الاتجاه الخامس: الاهتمام بالمناظرات، والحوار البنّاء مع الخصوم إحقاقاً للحقّ وإبطالاً للباطل:
فقد عمد الإمام إلى ذلك مع أبناء الديانات الأخرى كما في مناظرته لبعض علماء النصارى في دمشق الشام، وقد انتهت بفضيحة العالم النصرانيّ بين أصحابه وأهل ملّته حتّى قال لخواصّه: (جئتموني بأعلم منّي وأقعدتموه معكم حتّى يهتكني ويفضحني، وأعلمَ المسلمين أنّ لهم مَن أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا؟!، لا والله لا أُكلّمكم من رأسي كلمة، ولا قعدت لكم إنْ عشت سنة) [ينظر: الكافي ج8 ص122، دلائل الإمامة ص237]. وهكذا مع بعض رجالات التيارات والفرق المنحرفة في الإسلام، كما في مناظرته مع بعض رجال العامّة في الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) [ينظر: تفسير الإمام العسكريّ ص560، الاحتجاج ج2 ص66]، بل حتّى مع حكام عصره كما في مناظرته هشام بن عبد الملك حول طعام أهل المحشر يوم القيامة. [ينظر: الإرشاد ج2 ص163].
الاتجاه السادس: تنشئة وإعداد المتكلمين الصالحين والأكفاء من أبناء المذهب للمحافظة على هذه المنجزات:
لقد كانت أمواج الساحة العقديّة متلاطمةً ومشحونةً بالأفكار الكلاميّة والفلسفات الوضعيّة المختلفة، وكانت الزندقة والغلو والتطرّف تعصف بالكثير من أبناء المسلمين فتجرفهم بعيداً عن سواحل النجاة؛ ممّا جعل الأمّة بحاجةٍ شديدةٍ وملحّة إلى معرفة عقيدتها الحقّة الخالصة من شوب البدع والضلالات، فاقتضى الأمر قيام الإمام الباقر (عليه السلام) بإعداد جماعةٍ صالحةٍ للتصدّي لهذه المسؤوليّة الكبيرة، سواء لتبصرة الناس بعقائد الإسلام في المحافل والمجالس، أم لتوسعة رقعة مناظرة الخصوم، مضافاً إلى توجههم نحو التأليف لبعض الكتب الكلاميّة لتبقى مناراً للأجيال.
فكان من هؤلاء: زرارة بن أعين حيث كان من أبرز علماء الكلام وألّف كتاباً في الجبر والتفويض، قال النجاشيّ في ترجمته: (زرارة بن أعين ... شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيهاً متكلماً شاعراً أديباً، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقاً فيما يرويه. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله: رأيت له كتاباً في الاستطاعة والجبر) [رجال النجاشيّ ص175].
ومنهم مؤمن الطاق، عدّه النجاشيّ ممّن روى عن السجّاد والباقر والصادق (عليهم السلام) [رجال النجاشي ص325]، وقال عنه الشيخ الطوسي: (محمد بن النعمان الأحول، يلقب عندنا مؤمن الطاق، ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق ... وكان ثقة، متكلماً، حاذقاً، حاضر الجواب، له كتب، منها: كتاب الإمامة، وكتاب المعرفة، وكتاب الردّ على المعتزلة في إمامة المفضول، وله كتاب الجَمل في أمر طلحة والزبير وعائشة، وكتاب إثبات الوصية، وكتاب افعل ولا تفعل) [الفهرست ص207]، وله مناظراتٌ أخرى في الإمامة، ومواضيع غيرها واجه فيها أبا حنيفة والمرجّئة وغيرهم وذُكرت في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني.
هذا ما وفّقنا الله تعالى لتحريره في المقام، والحمد لله ربّ العالمين.
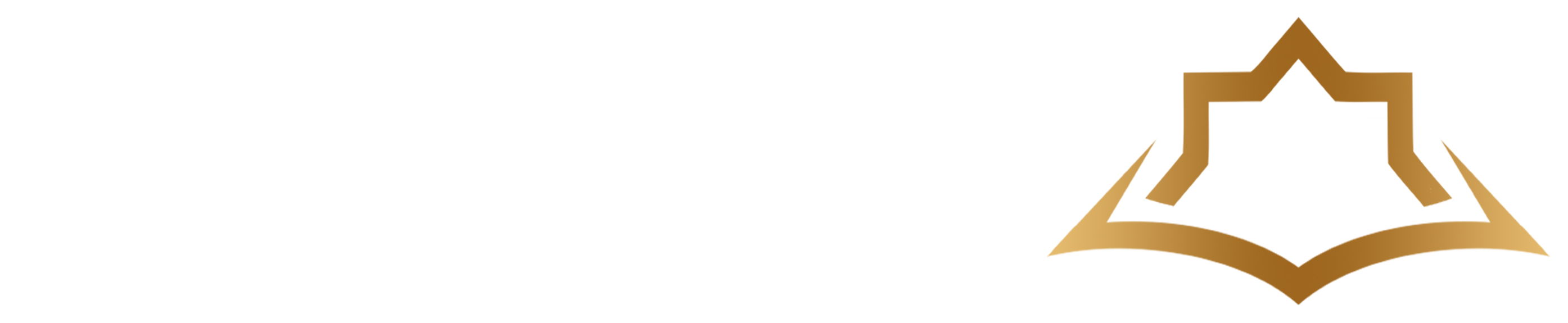


اترك تعليق