هل يمكن أنْ نقول إنّ الديمقراطيَّة مخالفةٌ للإسلام أو متّفقةٌ معه في عصر الغيبة؟ وهل هناك تطبيقاتٌ لها في عصر ما قبل الغيبة.. أو مشروعيتها فقط بسبب الغيبة وبقاء الناس بلا إمام يرى؟
هل يمكن أنْ نقول إنّ الديمقراطيَّة مخالفةٌ للإسلام أو متّفقةٌ معه في عصر الغيبة؟ وهل هناك تطبيقاتٌ لها في عصر ما قبل الغيبة.. أو مشروعيتها فقط بسبب الغيبة وبقاء الناس بلا إمام يرى؟
الجواب يتضّمن السؤال التمييز بين مرحلتين: الأولى، عصر ما قبل الغيبة. والثانية، عصر الغيبة الكبرى. في المرحلة الأولى، يتبنّى الإسلام - بمقتضى الأصل - نظاماً قائماً على القيادة الإلهيَّة المتمثلة بالنبيّ ثم الإمام المعصوم، حيث يكون الحكم قائماً على التشريع الإلهيّ، وليس مجرد توافقاتٍ بشريَّة. وعليه، فلم تكن فكرة الديمقراطيَّة بمعناها الحديث مطروحة في ظلِّ وجود الإمام؛ لأنَّ الحكم كان بيد من نصّبه الله قائداً للأمة، وهو المعصوم الذي يتصف بالعلم الكامل والعدالة المطلقة. أما في عصر الغيبة، فقد برزت الحاجة إلى نظامٍ يضمن تسيير شؤون المسلمين في ظلِّ غياب القائد المعصوم، وهنا جاءت فكرة قيادة الفقهاء، باعتبارهم الامتداد الطبيعيَّ للمرجعيَّة الدينيَّة والسياسيَّة، حيث يقوم الفقيه الجامع للشرائط بقيادة الأمة وفق الضوابط الشرعيَّة، مع مراعاة المصلحة العامة. لكن، في ظلِّ تعقيدات الواقع السياسيّ والاجتماعيّ، ظهرت أنظمة الحكم الحديثة، ومنها الديمقراطيَّة، التي تقوم على مبدأ حكم الأغلبيَّة من خلال الانتخابات والمؤسسات التمثيليَّة، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهماً: هل الديمقراطيَّة تتوافق مع الإسلام، أو أنها تتناقض معه؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من دراسة الديمقراطيَّة من حيث المفهوم والقيم، ومن حيث الآليات والممارسة العمليَّة، ثم مقارنتها بالنظام الإسلامي لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف. فعلى مستوى المفهوم، تقوم الديمقراطيَّة على مبدأ سيادة الشعب، حيث يُعتبر الشعب هو مصدر التشريع، في حين يرى الإسلام أنَّ السيادة الحقيقيَّة لله تعالى، وأنَّ الحكم يجب أنْ يستند إلى التشريع الإلهيّ، وليس إلى الإرادة المتغيرة للناس. وهذا الاختلاف الجوهريُّ يضعنا أمام إشكاليَّةٍ تتعلَّق بشرعية القوانين في النظام الديمقراطيّ، حيث يمكن أنْ تتغير التشريعات وفق إرادة الأغلبيَّة، حتى لو كانت هذه التشريعات مخالفةً للقيم الأخلاقيَّة والدينيَّة. ومن أبرز الإشكالات التي تواجه الديمقراطيَّة من منظورٍ إسلامي، مسألة حكم الأغلبيَّة، فالديمقراطيَّة تفترض أن رأي الأغلبيَّة هو الصواب، لكن الإسلام يرى أن الحقيقة لا تُعرف من خلال التصويت، وإنما من خلال المرجعيَّة الإلهيَّة، ولذلك قد تتخذ الأغلبيَّة قراراتٍ ظالمةً أو غير عادلة، كما حدث في العديد من المجتمعات التي أقرَّت قوانين تتعارض مع الفطرة الإنسانيَّة أو المبادئ الأخلاقيَّة، بحجّة أنَّ الأغلبيَّة أيدتها. كذلك، تقوم الديمقراطيَّة على النسبيَّة الأخلاقيَّة، حيث يمكن تغيير القوانين الأخلاقيَّة وفق إرادة الأغلبيَّة، في حين أنّ الإسلام يرفض هذه النسبيَّة، ويرى أن هناك قيماً ثابتة لا تتغير، مثل العدل، والصدق، والأمانة، والعفة، وغيرها من المبادئ التي لا تخضع لرغبات الناس. ومن جهةٍ أخرى، تدّعي الديمقراطيَّة أنها تضمن الحرية للجميع، لكن هذه الحرية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فوضى فكريَّةٍ وأخلاقيَّة، خصوصاً إذا لم تكن مقيدةً بضوابط شرعيَّة تحمي المجتمع من الانحراف. فمثلاً، في بعض المجتمعات الديمقراطيَّة، أُقرت قوانين تبيح الممارسات غير الأخلاقيَّة باسم الحرية الفرديَّة، مما أدى إلى انتشار الفساد الأخلاقيّ والتفكك الاجتماعي.~ أما على مستوى التطبيق، فإن الديمقراطيَّة تواجه عدَّة مشكلات، منها تأثير الإعلام والمال السياسيّ على العمليَّة الانتخابيَّة، مما يجعل قرارات الناخبين غير نزيهةٍ بالكامل، إضافةً إلى أنَّ القرارات السياسيَّة في الديمقراطيَّة كثيراً ما تخضع لمصالح الفئات الأقوى اقتصادياً أو إعلامياً، وليس لمصلحة المجتمع ككل. لكن رغم هذه الإشكالات، فإن الديمقراطيَّة قد تُقبل كوسيلة لتنظيم شؤون المسلمين في عصر الغيبة، بشرط أن تكون مقيدةً بالضوابط الإسلاميَّة، بحيث لا تسمح بتشريعاتٍ تناقض الشريعة، ولا تمنح السلطة المطلقة للأغلبيَّة، وإنما تكون أداةً لتحقيق العدل والاستقرار ضمن الإطار العام للشريعة الإسلاميَّة. وهذا يعني أن الديمقراطيَّة ليست بديلاً عن الحكم الإسلاميّ، وإنما يمكن توظيف بعض آلياتها كوسيلةٍ تنظيميَّة، وليس كإطار عقائديّ يُعتمد عليه بشكلٍ مطلق. وفي المحصلة الإسلام يمتلك نظامه السياسيَّ القائم على التشريع الإلهيّ وقيادة الفقهاء، لكنه قد يستفيد من بعض آليات الديمقراطيَّة لتنظيم شؤون الحكم في عصر الغيبة، بشرط أنْ تبقى هذه الآليات منضبطةً ضمن الإطار الشرعيّ، فلا تتحول إلى مصدر تشريعٍ مستقلٍ يناقض الأحكام الإلهيَّة.
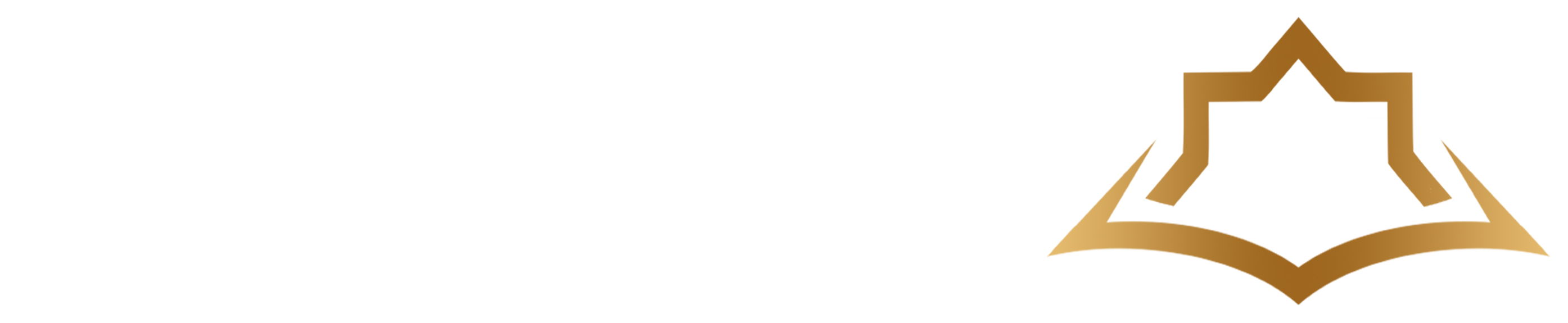


اترك تعليق