كيف يعلم النبيُّ بكلِّ شيءٍ والقرآن ينفي ذلك؟
يقول الله تعالى للنبيّ: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأحقاف:9]، بينما تُظهر الأحاديث عند الشيعة أنَّ النبيّ كان عالماً بكلِّ شيءٍ في الكون؛ لأنَّه يمتلك الولاية عليه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية لابدَّ أنْ يعلم السائل بأنَّنا نعتقد بأنَّ العَالِم بكلِّ شيءٍ على وجه الأصالة والاستقلال هو الله تعالى لا شريك له في ذلك، كما ونعتقد بأنَّ النبيَّ الأعظم (صلَّى الله عليه وآله) يعلم بكلِّ شيءٍ ـ عدا ما اختصَّه الله لنفسه ـ بإذنٍ وتفويضٍ من الله تعالى وليس مستقلاً عنه، ودونك مؤلَّفات الإماميَّة في هذا المجال.
إذا بان هذا الأمر فنقول: لقد دلَّت الآيات العديدة والروايات الكثيرة على سعة علم النبيِّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله):
فمن الآيات:
1ـ قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255].
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما هذا لفظه: (قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ دليلٌ على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ماضيها، وحاضرها، ومستقبلها، كقوله إخباراً عن الملائكة: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً﴾ [مريم:64]. وقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ أي: لا يطَّلع أحدٌ من علم الله على شيءٍ إلَّا بما أعلمه الله (عزَّ وجلَّ) وأطلعه عليه) [تفسير ابن كثير ج1 ص679].
2ـ وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ [الجنّ: 26 ـ 27].
قال ابن كثير في تفسيرها أيضاً: (قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾، هذه كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، وهكذا قال هاهنا: إنَّه يعلم الغيب والشهادة، وإنَّه لا يطَّلع أحدٌ من خلقه على شيءٍ من علمه إلَّا مما أطلعه تعالى عليه، ولهذا قال: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾، وهذا يعمُّ الرسول الملكيَّ، والبشريَّ) [تفسير ابن كثير ج8 ص247].
وأمَّا الروايات:
فقد ورد في بعض روايات العامَّة أنَّ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) كان يعلم بكلِّ شيءٍ؛ ولذلك يطلبُ من الصحابة أنْ يسألوه عن كلِّ شيءٍ يخطر في أذهانهم، فما هذا إلَّا إشارة إلى سعة علمه (صلَّى الله عليه وآله) الذي علَّمه الله إيَّاه.
فقد روى البخاريُّ في الصحيح بسنده عن أنس بن مالك، وفيه: «أنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم) خرج حين زاغت الشمس، فصلَّى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أنَّ فيها أموراً عظاماً، ثمَّ قال: من أحبَّ أنْ يسأل عن شيءٍ فليسأل، فلا تسألوني عن شيءٍ إلَّا أخبرتكم ما دمتُ في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أنْ يقول: سلوني.
فقام عبد الله بن حذافة السهميُّ فقال: من أبي؟!
قال: أبو حذافة. ثمَّ أكثر أنْ يقول: سلوني.
فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربَّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمَّدٍ نبيَّاً، فسكت. ثمَّ قال: عرضت عليَّ الجنَّة والنَّار آنفاً، في عرض هذا الحائط، فلم أرَ كالخير والشر» [صحيح البخاريّ ج1 ص200].
أمَّا عندنا فالأمر أوضح، فقد روى شيخنا الصفَّار (طاب ثراه) بسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سُئل عليٌّ (عليه السلام) عن علم النبيِّ (صلَّى الله عليه وآله) فقال: عَلِمَ النبيُّ عِلْمَ جميع النبيين، وعلم ما كان، وعلم ما هو كائنٌ إلى قيام الساعة، ثمَّ قال: والذي نفسي بيده إنِّي لأعلم علم النبيِّ (صلَّى الله عليه وآله) وعلم ما كان، وما هو كائنٌ فيما بيني وبين قيام الساعة» [بصائر الدرجات ص ١٤٧].
ومن خلال ما تقدَّم من الآيات والروايات يتَّضح الحال في الآية محلِّ السؤال، إذْ المراد منها نفي العلم بالغيب عنه (صلَّى الله عليه وآله) بشكلٍ مستقل، دون ما كان مستنداً لتعليم الله تعالى إياه؛ وذلك لأنَّ الآية الكريمة نفت عنه العلم أوَّلاً ثـمَّ أثبتت له العلم من الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾.
قال صاحب الميزان فيها: (ونفي الآية العلم بالغيب عنه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لا ينافي علمه بالغيب من طريق الوحي، كما يصرِّح تعالى به في مواضع من كلامه كقوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 44، يوسف: 102]، وقوله: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ [هود: 49]، وقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 27]، ومن هذا الباب قول المسيح (عليه السلام): ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: 49]، وقول يوسف (عليه السلام) لصاحبي السجن: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا﴾ [يوسف: 37].
وجه عدم المنافاة: أنَّ الآيات النافية للعلم بالغيب عنه وعن سائر الأنبياء (عليهم السلام) إنَّما تنفيه عن طبيعتهم البشريَّة، بمعنى أنْ تكون لهم [أي العلم بالغيب] طبيعة بشريَّة، أو طبيعة هي أعلى من طبيعة البشر، من خاصَّتها العلم بالغيب بحيث يستعمله في جلب كلِّ نفع ودفع كلِّ شرٍّ، كما نستعمل ما يحصل لنا من طريق الأسباب، وهذا لا ينافي انكشاف الغيب لهم بتعليمٍ إلهيٍّ من طريق الوحي، كما أنَّ إتيانهم بالمعجزات فيما أتوا بها ليس عن قدرةٍ نفسيَّةٍ فيهم يملكونها لأنفسهم بل بإذنٍ من الله تعالى وأمر ... ويشهد بذلك: قوله بعده متصلاً به: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾، فإنَّ اتصاله بما قبله يعطي أنَّه في موضع الإضراب، والمعنى: إنِّي ما أدري شيئاً من هذه الحوادث بالغيب من قبل نفسي وإنَّما أتَّبع ما يوحى إليَّ من ذلك) [تفسير الميزان ج18 ص191].
والنتيجة من كلِّ ذلك، أنَّ الآية الكريمة تنفي عن الأنبياء (عليهم السلام) العلم بالغيب على وجه الاستقلال والأصالة، وتثبتها لهم بإذن الله تعالى ووحيه، كما هو واضح.. والحمد لله ربِّ العالمين.
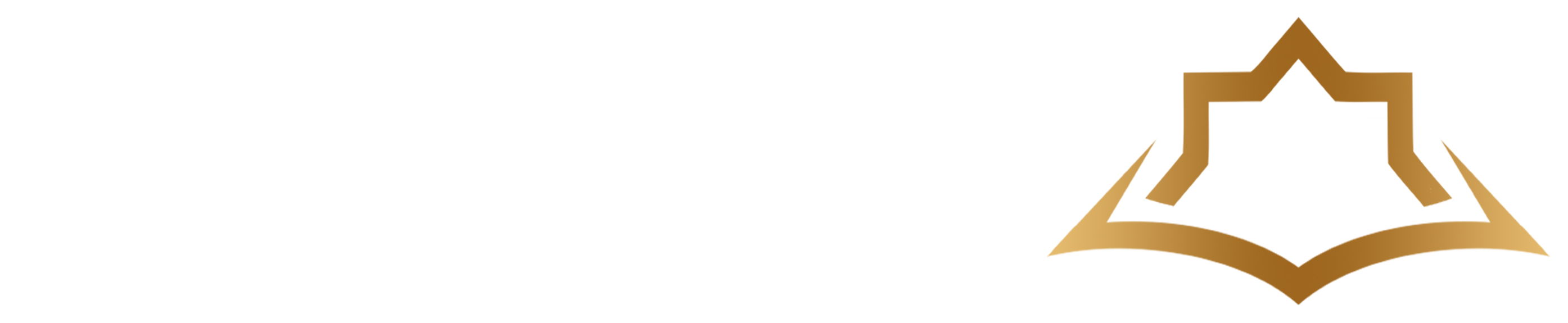


اترك تعليق