التشكيك في نهج البلاغة
السؤال: ما الأسباب التي جعلت بعض المشكّكين في كتاب (نهج البلاغة) يزعمون أنَّه ليس من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل هو من وضع الشريف الرضيّ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أثارت بعض الأقلام زوبعةً من غبار التشكيك في وجه (نهج البلاغة)؛ ليطمسوا ضياء شمس بلاغته بليل الكسوف، ويَطلسوا نور بدر فصاحته بعتمة الخسوف. وكان طليعة قافلة المشكّكين، وربيئة ركب المُضلّلين ابن خلَّكان، حيث زعم هناك في ترجمة السيّد الشريف المرتضى أنَّه: (قد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام عليّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه)؛ هل هو جمْعُهُ أو جمْعُ أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنَّه ليس من كلام عليٍّ، وإنّما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه) [وفيات الأعيان ج3 ص313].
وكان عليه أولاً أنْ يُثبتَ أنَّ (نهج البلاغة) ليس من كلام أمير المؤمنين (ع)، ثمَّ يُثنّي أخرى للخوض في مَن وضعه، على أنَّنا لسنا ندري من هؤلاء النَّاس، أَهم العلماءُ منهم والمحقّقون؟ أم هم أهل السِيَر منهم والمتأدّبون حتى نُصغي لما قالوا بشيءٍ من الاهتمام، ونقرأ ما زعموه بشيءٍ من التدبُّر؟
ولكنَّ ابن أبي الحديد – وكان معاصراً لابن خلَّكان – سلَّط أشعَّةً من الحقيقة على نفسيَّات هؤلاء فوصفهم ب «أرباب الهوى» و «مَن أعمت العصبيَّة أعينهم»، وأبان مبلغ علمهم فبيَّن قلّة معرفتهم بأساليب الكلام؛ فقال: (كثيرٌ من أرباب الهوى يقولون: إنَّ كثيراً من نهج البلاغة كلامٌ محدَثٌ، صنعه قومٌ من فصحاء الشيعة. وربَّما عزوا بعضه إلى الرضيّ أبي الحسن أو غيره. وهؤلاء أعمتْ العصبيَّةُ أعينَهم، فضلُّوا عن النهج الواضح، وركبوا بنيات الطريق، ضلالاً وقلَّة معرفةٍ بأساليب الكلام) [شرح نهج البلاغة ج10 ص127].
ذلك أنَّ كلاماً تزهرُ رياض ألفاظه في ربيع الفصاحة، وتصدح قيثار معانيه بترانيم البلاغة، كيف يطيب لمن وضعه أنْ ينسِبه لغيره - أيَّاً كان - كالإمام (عليه السلام) أو السيّدين الشريفين؟
وإن قيل: إنَّ ذلك كان لدوافع عقائديَّةٍ نصرةً للتشيّع بأنْ يضعوا كلاماً على لسان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكون كالشاهد على عقائدهم، والدليل على حُجَّتهم، فيستنير به مصباح برهانهم، ويستطيل به ظلُّ مقالتهم.
كان جواب ذلك: هذا يجري في مثل الخطبة الشقشقيَّة وما أشبهها، وهو قليلٌ في نهج البلاغة إذا ما قيس على كلّه، لا في مثل وصف الطاووس والنَّمل وما أشبه تلك الموضوعات التي لا علاقة لها بالعقائد، ولا مساس لها بالمقالات.
ونسج اليافعيُّ على نَوْل ابن خلَّكان، وفتلَ حبل دعواه، فردَّد – كالببغاء – قول "الوَفَيَات"، فقال: (وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام عليّ بن أبي طالب، هل هو جمعه أو أخوه الرضي؟ وقيل: إنَّه ليس من كلام عليّ بن أبي طالب، وإنما أحدهما هو الذي وضعه ونسبه إليه) [مرآة الجنان ج3 ص43].
ثم تدور رحى التشكيك حتى يطلع قرنُها على أفق سطور مؤلَّفات الذَّهبيّ، قال في ترجمة السيد المرتضى: (قلتُ: هو جامع كتاب نهج البلاغة، المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي (رضي الله عنه)، ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطلٌ، وفيه حقٌّ، ولكن فيه موضوعاتٌ حاشا الإمام من النطق بها... وقيل: بل جمع أخيه الشريف الرضي) [سير أعلام النبلاء ج17 ص589].
وقال في الميزان في ترجمة السيد المرتضى أيضاً: (وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، وله مشاركةٌ قويةٌ في العلوم، ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنَّه مكذوبٌ على أمير المؤمنين عليٍّ (رضي الله عنه)، ففيه السبُّ الصراح، والحطُّ على السيّدين: أبي بكرٍ وعمر (رضي الله عنهما)، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفةٌ بنفس القرشيّين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأنَّ الكتاب أكثره باطل) [ميزان الاعتدال ج3 ص124].
وتلقَّف هذه الأضاليل تلقّف الطفل ثدي أمّه بعضُ المعاصرين، وردَّدوا تلك النغمة نفسها، كأحمد أمين، وشوقي ضيف وغيرهما.
وسنبيّن – بعونه تعالى – على وجه الاختصار التبريرات غير المنطقيَّة وراء التشكيك المُزيَّف في نهج البلاغة، ثمَّ نبيّن الدافع الحقيقيَّ وراء ذلك.
الأول: قالوا: إنَّ فيه سجعاً، وهو لا يتلاءم وطبيعة العصر الذي عاش فيه الإمام عليٌّ (عليه السلام).
ولستُ أريد الخوض في مسألة هل السجع موجودٌ في القرآن – كما عليه البلاغيُّون – أم غير موجودٍ، وإنَّما الذي هو في القرآن الكريم صورة السجع لا السجع نفسه؛ لأنَّ المعنى إنْ كان تابعاً للفظ فهو سجعٌ كما في كلام العرب، وإنْ كان فيه اللفظ تابعاً للمعنى هو صورة سجع كما في القرآن، وهذا الذي عليه الرمانيُّ حيث قال: (ذهب الأشعريَّة إلى امتناع أنْ يقال: في القرآن سجع ، وفرَّقوا بأنَّ السجع هو الذي يقصد فيه نفسه ، ثم يحال المعنى عليه ، والفواصل التي تتبع المعاني ، ولا تكون مقصودة في نفسها... ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا). [ينظر: الإتقان في علوم القرآن ج2 ص188].
وتبعه الباقلانيُّ فقال: (السجع من الكلام يتّبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدّى السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن؛ لأنَّ اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى، وفصلٌ بين أنْ ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّى المعنى المقصود فيه، وبين أنْ يكون المعنى منتظماً دون اللفظ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع، كانت إفادة السجع كإفادة غيره ، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى) [إعجاز القرآن ص58].
وهذا الرأي له خلفيَّةٌ عقائديَّة لا بلاغيَّة، وهو نزاعٌ لفظيٌّ، فالبلاغيُّون يسمُّونه سجعاً، والرمانيُّ والأشاعرة ومنهم الباقلانيُّ يسمُّونه فاصلة، وعلى أيَّة حالٍ: هل خلا القرآن الكريم -وهو تاج البلاغة على مفرق آداب العربيَّة- من السجع؟ وهل خلا منه الحديث الشريف وزبر الأوّلين من بلغاء العرب في خطبهم وأشعارهم ومنثورهم؟
إنَّ السجع الذي يعيبه أهل الذوق نوعان:
أحدهما: سجع الكُهَّان؛ لما فيه من الباطل الذي يُعارض به الحق، وهذا قولٌ رواه بعضهم عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فالذمُّ متجهٌ لا لذات السجع، بل لذاك الذي يعارض به الحقّ وكان من مصاديقه سجع الكُهَّان [ينظر: الاستذكار ج7 ص357]. وإلَّا – لو كان الذمُّ متجهاً للسجع نفسه - لقال (صلى الله عليه وآله): (أسجعاً؟) فيعمُّ – للتنكير – السجع كلَّه بالذمّ، ولكنَّه (صلى الله عليه وآله) رُوي عنه: «أسجع كسجع الكهّان؟».
وثانيهما: التكلّف في السجع، فإنَّه إذا لم يخرج الكلام المسجوع عن لطف قريحةٍ، وحسن مذاق، فإنَّه يكون مرذولاً عند الطبع السليم، ساقطاً بين أهل الصنعة.
وليس السجع إذا كان في غير هذين النوعين مما يُعاب، وما أبعد ما قال هؤلاء وما قاله أبو هلال العسكريُّ عن السجع، فاسمعه يقول: (لا يحسن منثور الكلام، ولا يحلو حتّى يكون مزدوجاً، ولا تجد لبليغٍ كلاماً محلولاً من الازدواج، وناهيك أنَّ القرآن الكريم الذي هو عنصر البلاغة ومناط الإعجاز مشحونٌ به، لا تخلو منه سورة من سوره وإنْ قصرت، بل ربما وقع السجع في فواصل جميع السورة، كما في سورة النجم والرحمن وغيرها من السّور) [الصناعتين ص260].
ونهج البلاغة فيه أرقى أنواع السجع الثلاثة التي ذكرها البلغاء وأعلاها، ألا وهو التصريع حيث تكون القرينتان فيه متفقتين في الرويّ، مستويتي الأوزان، متعادلتي الأجزاء، ومنه: قوله تعالى {إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ} [الغاشية: 25-26]. وما رُوي عن النبيِّ (صلَّى اللَّه عليه وآله سلَّم) من قوله للأنصار: «إنَّكم لتكثُرونَ عند الفزع، وتقلَّونَ عند الطَّمع» [الفائق في غريب الحديث ج3 ص29]. وقول الإمام عليٍّ (عليه السلام): «كأنّي بكِ -يا كوفةُ- تُمدِّينَ مدّ الأديم العُكاظيّ، تُعرَكينَ بالنوازل وتُركبين بالزلازل، وإنّي لأعلمُ أنّه ما أراد بك جبّارٌ سوءاً إلّا ابتلاه الله بشاغلٍ ورماه بقاتلٍ» [نهج البلاغة ص86].
فكما أنَّ في الآية التي سلفت كان التزاوج والاستواء والاعتدال في (إلينا، وعلينا)، و(إيابهم وحسابهم)، وفي قوله (صلى الله عليه وآله) كان ذلك بين (تكثرون وتقلّون)، و(الفزع والطمع)، كذلك كان التزاوج عينه في كلام الإمام (ع) في (تُعركين وتركبين)، و(النوازل والزلازل)، و(ابتلاه ورماه)، و(شاغل وقاتل).
الثاني: الركاكة:
وأمَّا الزعم بأنَّه ركيك، كما رعفت به يراع الذهبيّ من قبل، وتبعه عليه شوقي ضيف من بعد، فليت شعري، هذه طروس نهج البلاغة الموشَّاة بديباج البيان، وهذه سطوره المطرَّزة بذهب الذلاقة، أيَّة فهاهةٍ وجد في حنايا كلماتها؟ وأيُّ عيٍّ رأى في طيَّات معانيها؟
أترى عاب قوله (عليه السلام): «مَن ضاق عليه العدلُ فالجورُ عليه أضيقُ) [نهج البلاغة ص57]، هذه الكلمة الذهبيَّة التي جرت مجرى الأمثال؟ أم غيرها ممَّا يجري مجراها؟
ولو أراد أديبٌ، وشاء صاحبُ فطنة أنْ يستخرجا لك منه الكلام الذي يجري مجرى الحكمة ويسير مسرى المثل لصنَّفا لك منه الشيء الكثير، بل لقد صنَّف بعضُهم شيئاً من ذلك، ولعلَّ آخرهم الشيخ محمد الغرويّ الذي صنَّف كتاب (الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة).
أم تراه عاب قوله (عليه السلام): «فإنّ الغايةَ أمامَكم، وإنّ وراءَكم الساعةَ تحدُوكُم، تخفّفوا تلحقوا، فإنّما يُنتظَر بأوّلكم آخرُكم»، التي ملكت على السيد الشريف لبَّه، وغلبت على قلبه حتى أصحر بما في مكنون نفسه من الإعجاب بها، وأبرز ما في ضميره من التعليق عليها فقال: (إنَّ هذا الكلام لو وُزن -بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله ( ص )- بكلِّ كلامٍ، لمال به راجحاً وبرز عليه سابقاً) [نهج البلاغة ص63].
ولقد أعجِب بفصاحته الشيخ محمد عبدة، فقال من كلمةٍ له: (فكان يُخيَّلُ إليَّ في كلِّ مقامٍ أنَّ حروباً شبَّت، وغاراتٍ شُنَّت، وأنَّ للبلاغة دولة، وللفصاحة صولة، وأنَّ للأوهام عرامة، وللريب دعارة، وأنَّ جحافل الخطابة، وكتائب الذرابة، في عقود النظام وصفوف الانتظام، تنافح بالصفيح الأبلَج، والقويم الأملَج. وتمتلجِ المُهج برواضع الحُجج.. وأنَّ مدبّر تلك الدولة، وباسل تلك الصولة، هو حامل لوائها الغالب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) [نهج البلاغة (بشرح محمد عبدة) ج1 ص3].
وما أحسن قول الشاعر:
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً * وآفته من الفهم السقيم
الثالث: فيه مصطلحاتٌ فلسفيَّة لا عهد للعرب بها
قالوا: إنَّ فيه اصطلاحاتٍ فلسفيَّةً كالكيف والأين، مما لا عهد للعرب بها، فقد عرفت هذه المصطلحات بعد دخول الفلسفة إليهم عن طريق الترجمة في عهد المأمون.
والحق، أنَّ العربيَّ الذي كان يعبد الوثن، ويتَّخذ من الصنم الذي يصنعه من التمر ويأكله إلهاً يعبد، وربَّاً يُقصد لا يستطيع – وقد غرق في الماديَّة إلى شحمة أذنه، ولا ينظر للأمور أبعد من أرنبة أنفه – فكيف له أن يستأنس الأمور المجرَّدة، والكليَّات العقليَّة؛ وقد انعكس هذا حتى على الخلف منهم، فتراهم – تأثُّراً بتلك النزعة الماديَّة – يزعمون أنَّ لله تعالى وجهاً، ويداً، وعينا، غايته أنَّها ليست كالعيون والأيدي والأوجه.
أما مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان يرى زغب الملائكة، ويسمع صوت الوحي، فما أسهل أنْ يتعقَّل المعاني الكليَّة المجرَّدة، ويستأنس بالمفاهيم الغيبيَّة العاليَّة؛ لذا سهل عليه أنْ يُلبس ما فهمه من تلك المعاني ثوباً من الألفاظ تكون قوالب لها، لا تزيد عليها فتوحي معنىً غير مراد، ولا تقصر عنها فتأتي بمفادٍ غير مقصود، فهو ابن بجدتِها، وأبو عذرها، ومنه السبق في اختراع هذه الألفاظ، وإليه المنتهى في فهم معانيها، فالعجب أنْ لم يجئنا منه تراثٌ كثير، بل العجب كيف وصلنا منه هذا القليل.
ولو أنّهم خلعوا عنهم عقال التعصب، ولبسوا ثياب الإنصاف، وخرجوا عن كلام الأعرابيّ البوَّال على عقبيه، وانتجعوا ربوة المعارف العالية، وارتبعوا خصيب العلوم النافعة لوجدوا أشباه هذه الكلمات الرائقة والمعاني الفائقة في كلام رضيعة ثدي الوحي، وربيبة حجر النبوَّة السيدة الزهراء (عليها السلام) فانظر قولها: «الممتنع من الأبصار رؤيتُه، ومن الألسن صفتُه، ومن الأوهام كيفيّتُه. ابتدع الأشياءَ لا من شيءٍ كان قبلَها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلةٍ امتثلها، كوّنها بقدرته، وذرأها بمشيّته، من غير حاجةٍ منه إلى تكوينها، ولا فائدةٍ له في تصويرها، إلّا تثبيتاً لحكمته، وتنبيهاً على طاعته» [الاحتجاج ج1 ص133].
وانظر إلى قول الإمام الحسن (عليه السلام) وهو من ماء هذا الكلام وفراته، وفرع شجرة هذه البيان وغصنه وقد جاء اليه رجلٌ فقال له: يا ابن رسول الله، صف لي ربّك كأنّي أنظر إليه؟ فأطرق الإمام الحسن (عليه السلام) مليّاً، ثمّ رفع رأسه فأجابه: «الحمد لله الذي لم يكن له أوّلٌ معلوم، ولا آخرٌ متناه، ولا قَبلٌ مدرك، ولا بَعدٌ محدود، ولا أمدٌ بـ حتّى، ولا شخصٌ فيتجزّأ، ولا اختلاف صفة فيتناهى، فلا تدرك العقول وأوهامها، ولا الفكر وخطراتها، ولا الألباب وأذهانها صفته، فيقول: متى، ولا بدئ ممّا، ولا ظاهر على ما، ولا باطن فيما، ولا تارك فهلاّ، خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً، ابتدأ ما ابتدع، وابتدع ما ابتدأ، وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد» [التوحيد للصدوق ص45].
وانظر – بعد ذلك – خطبة الإمام الحسين (عليه السلام) في التوحيد: «لا تُحلّه (في)، ولا تُوقّته (إذ)، ولا تُؤامرُه (إنْ)، عُلوّه من غير توقّلٍ، وَمجيئُه من غير تنقّلٍ، يوجد المفقودَ ويُفقِدُ الموجودَ، ولا تجتمعُ لغيره الصفتان في وقتٍ، يُصيب الفكرُ منه الإيمانَ به موجوداً، ووجودُ الإيمان لا وُجودُ صفةٍ، به تُوصَفُ الصفات لا بها يُوصَف، وبه تُعرَف المعارف لا بها يُعرَف، فذلك الله لا سميّ له، سبحانه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» [تحف العقول ص245].
فهؤلاء الميامين الأربعة، ممن عاش عصر النبوَّة الزاهر، وشهد شروق شمس الرسالة تكلَّموا جميعاً بهذه المصطلحات التي زعم من لا إطلاع له أنَّها لم تتكلَّم بها العرب بشفة، ولا ترنَّمت بها بلسان.
إذن، لقد سنَّ للفلاسفة المسلمين هذه المصطلحات أمير المؤمنين (عليه السلام) فعبَّد سبلها، ومهَّد طرقها، فعرَّف العرب إلى هذه المعاني المستحدثة، وأدخلهم في حوزة هذه الألفاظ البديعة، وجرى على سننه، وقصَّ آثار خطوته أهل بيته (عليه وعليهم السلام)
الرابع: ليس للنَّهج أسانيد
وليس حذف الأسانيد من الكتب ممَّا يضعف من قيمتها خصوصاً إذا كانت مرعىً للحكمة، ومراحاً للأدب، فإنَّما يُطلب ذلك في العقيدة والفقه، وما كان السيد الشريف بدعاً من غيره من المؤلّفين، فهذا ابن الأثير حذف أسانيده من كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول)، وهو أولى من السيد الشريف بذكر الأسانيد، وإن كان عذره ما بيَّنه في المقدّمة من قوله: (لما وفق الله سبحانه وتعالى للشروع في هذا الكتاب، وسهل طريقه، فكنت فيه طالباً أقرب المسالك وأهداها إلى الصواب، أول ما بدأت به أنني حذفت الأسانيد، كما فعله الجماعة المقدَّم ذكرهم -رحمة الله عليهم-، ولنا في الاقتداء بهم أسوة حسنة، لأن الغرض من ذكر الأسانيد كان أولاً لإثبات الحديث وتصحيحه، وهذه كانت وظيفة الأولين -رحمة الله عليهم-، وقد كفونا تلك المؤنة، فلا حاجة بنا إلى ذكر ما قد فرغوا منه، وأغنونا عنه) [جامع الأصول ج1 ص53]. وهو عملٌ غير صالحٍ، فثبوت الحديث على مبنى مصنّف الكتاب لا يلازمه ثبوته عند قارئه؛ لأن استنباط الحكم متوقفٌ على صحة السند.
وهذا السمعانيُّ في مقدّمة كتابه الأنساب يقول: (فشرعت في جمعه بسمرقند في سنة خمسين وخمسمائة، وكنتُ أكتب الحكايات والجرح والتعديل بأسانيدها، ثم حذفتُ الأسانيد لكي لا يطول) [الأنساب ج1 ص19]، ومن جدَّ في البحث عن الكتب المحذوفة الأسانيد وجد.
على أنَّ أهمَّ خطبه -وهي الشقشقيّة- كانت موجودةً قبل السيد الرضيّ بآمادٍ طويلةٍ.
(قد وجدتها في موضعين تاريخهما قبل مولد الرّضيّ بمدّة أحدهما: إنّها مضمنة كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبَّة تلميذ أبي القاسم الكعبيِّ أحد شيوخ المعتزلة، وكانت وفاته قبل مولد الرّضيّ.
الثاني: إنّي وجدتُها بنسخةٍ عليها خط الوزير أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الفرات، وكان وزير المقتدر بالله، وذلك قبل مولد الرّضيّ بنيف وستين سنة، والذي يغلب على ظنّي أنّ تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة، انتهى.
وقال الشّارح المعتزلي حدّثني شيخي أبو الخير مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة، قال: قرأتُ على الشّيخ أبي محمّد عبد اللَّه بن أحمد المعروف بابن الخشَّاب هذه الخطبة، فقلتُ له: أتقول إنّها منحولة؟
فقال: لا والله، وإني لأعلم أنّه كلامه كما أعلم أنّك مصدّق، قال: فقلت: له إنّ كثيراً من النّاس يقولون: إنّها من كلام الرّضيّ، فقال: أنّى للرضيّ ولغير الرّضيّ هذا النّفس وهذا الأسلوب، قد وقفنا على رسائل الرضيّ وعرفنا طريقته وفنّه في المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خلّ ولا خمر، قال: واللَّه لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنّفت قبل أن يخلق الرضيّ بمائتي سنة، ولقد وجدتُها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هي من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النّقيب أبو محمّد والد الرضيّ.
قال الشّارح: قلت: وقد وجدتُ أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة، وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضيّ بمدّة طويلة، ووجدتُ أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلَّمي الاماميّة وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب الإنصاف، وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبى القاسم البلخيّ ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ رحمه الله موجوداً) [منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج2 ص346].
الخامس: الحطُّ على أبي بكرٍ وعمر
قالوا: إنَّ فيه حطَّاً على أبي بكرٍ وعمر، وهذا ما عهدناه من النهج، بل الذي عهدناه خلافه، وهو مدح الثاني وذلك في قوله (عليه السلام): «للهِ بلاءُ فلانٍ، فلقد قوَّمَ الأَوَدَ، وداوَى العَمَدَ..».
وفيه أولاً: ليس بمستحيلٍ في العقل، ولا بمستبعدٍ في العادة أنْ يمدح الإنسان رجلاً ثمَّ يذمُّه، فقد رُوي: «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سأل عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر، فقال: إنَّه لمانعٌ لحوزته، مطاعٌ في أدنيه. قال الزبرقان: إنَّه -يا رسول الله- ليعلم منّي أكثر ممّا قال، ولكنه حسدني شرفي، فقصّر بي. قال عمرو: هو –والله- زمر المروءة، ضيّق العطن، لئيم الخال. فنظر النبيُّ (صلّى الله عليه وآله) في عينيه، فقال: يا رسول الله، رضيتُ فقلتُ أحسن ما علمتُ، وغضبتُ فقلت أقبح ما علمتُ، وما كذبتُ في الأولى ولقد صدقتُ في الآخرة. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إنّ من البيان لسحراً» [بحار الأنوار ج56 ص278].
فالشاهد أنَّه لا يقدح في الإنسان أنْ يمدح رجلاً مرَّةً ويذمُّه أخرى؛ لاختلاف الحال.
على أنَّه لم يثبت أنَّ الإمام عليَّاً (عليه السلام) أراد بهذا الكلام عمرَ، ولا دليل عليه.
على أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حطَّ على الشيخين بما هو أغلظ من هذا لحناً وأشدّ منه قولاً، لا في نهج البلاغة، بل في صحيح مسلم بشهادة عمر أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) والعبَّاس رأيا أبا بكرٍ وعمر كاذبينِ آثمينِ غادرينِ خائنينِ! فهل من حطٍّ أعظم من هذا وأشدّه؟ فقد ورد عن عمر: «فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحقّ، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله (ص) وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحقّ» [صحيح مسلم ج5 ص152].
وهذا هو السبب الواقعيُّ للتشكيك في نهج البلاغة والطعن عليه.
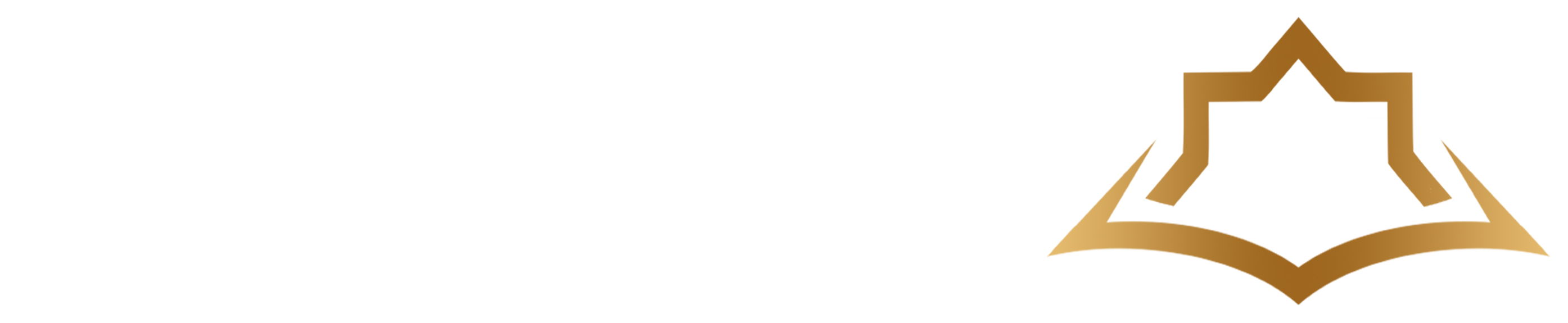


اترك تعليق