لماذا صبر الإمام علي (ع) وضحّى الإمام الحسين (ع)؟
السؤال: الإمام عليٌّ بايعَ وسالمَ حين لم يجد أعواناً فقال: «فنظرتُ فإذا ليس لي رافدٌ ولا ذابٌّ ولا مساعد إلا أهل بيتي فضننتُ بهم عن المنية، فأغضيتُ على القذى، وجرعت ريقي على الشجى»، فهنا معصومٌ ضنَّ بأهل بيته عن المنية، وهناك المعصوم الثالث (الحسين) أخرج أهل بيته الى المنية، فأيُّهما مصيب؟
الجواب:
كلاهما مصيب؛ لأنَّ كلَّ إمامٍ تصرّف وفق تكليفه الإلهيّ وظروف زمانه، ولا تناقض بين موقف أمير المؤمنين عليٍّ (عليه السلام) وموقف الإمام الحسين (عليه السلام)، بل كان لكلٍّ منهما حكمةٌ تقتضيها طبيعة المرحلة التي عاشها.
وهذا يشبه ما أشرنا إليه سابقاً في مسألة صلح الإمام الحسن (عليه السلام) وقيام الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث يتوهم البعض وجود تناقض، بينما الواقع أنَّ الاختلاف في الموقف ناشئٌ عن اختلاف الظروف والسياقات الزمنية، وليس عن اختلافٍ في الرؤية أو الهدف.
فالإمام عليٌّ (عليه السلام) عندما رأى خذلان الناس له بعد السقيفة وفقدان الناصر، أدرك أنَّ المواجهة لن تؤدي إلى نتيجةٍ سوى إهلاك نفسه وأهل بيته دون تحقيق هدفٍ إصلاحيّ، فاضطر للصبر حفاظاً على الإسلام وعلى أهل البيت الذين كان لهم دورٌ مستقبليٌّ في استمرار الرسالة، وقد عبَّر عن ذلك بقوله: «فنظرتُ فإذا ليس لي رافدٌ ولا ذابٌّ ولا مساعدٌ إلَّا أهل بيتي، فضننُت بهم عن المنية، فأغضيتُ على القذى وجرعتُ ريقي على الشجى» [نهج البلاغة خ26].
كما أوضح موقفه من ذلك في خطبته الشقشقية حيث قال: «وطفقتُ أرتئي بين أنْ أصول بيدٍ جذَّاء، أو أصبر على طخيةٍ عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمنٌ حتى يلقى ربَّه! فرأيتُ أنَّ الصبر على هاتا أحجى، فصبرتُ وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا..» [نهج البلاغة خ3].
وهذا النصّ يوضح أنَّ الإمام عليَّاً (عليه السلام) كان مدركاً أنَّ اللجوء إلى المواجهة المسلحة في تلك المرحلة لن يسهم في حماية الإسلام، بل قد يتسبّب في اضطرابٍ خطيرٍ يهدّد مصيره، فضلاً عن استئصال أهل البيت (عليهم السلام) دون تحقيق أيَّة نتيجةٍ إيجابية، فآثر الصبر واتخاذ نهجٍ سياسيٍّ يضمن بقاء الدين واستمراره.
كما يؤكّد هذا الموقف ما قاله في رسالته إلى أصحابه عندما دعوه للخروج على معاوية بعد التحكيم: «أما بعد، فقد جاءتني كتبكم وفهمت مقالة من لقِيتُ منكم، أنَّكم جئتم تريدون أنْ تخرجوا إلى عدوكم، فقد رأيت أنْ أمسك حتى يتمهَّد الأمر، ويكملَ العدد» [نهج البلاغة ك28]. وهذا يبيّن أنَ الإمام كان يدرك متى يتحرَّك ومتى يصبر، وأنَّ كلَّ خطوةٍ تحتاج إلى ظروفٍ مناسبةٍ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أما الإمام الحسين (عليه السلام)، فقد واجه وضعاً مختلفاً تماماً، إذ كان الدين في خطرٍ وجوديٍّ، وكانت الأمة قد استُعبدت لبني أمية، وكانت بيعة يزيد تعني القضاء على ما تبقى من الإسلام الحقيقي. وهنا كان تكليفه هو القيام، وكان يعلم أنّ دمه ودم أهل بيته سيوقظ الأمة ويفضح الظلم، وهو ما حصل بالفعل، حيث كان قيامه الشرارة التي قلبت المعادلة على بني أمية وأعادت للأمة وعيها.
إذن، الإمام عليٌّ (عليه السلام) صان أهل بيته ليحفظ وجودهم من أجل المستقبل، بينما الإمام الحسين (عليه السلام) قدّم أهل بيته ليكونوا مشاعل هدايةٍ وإنقاذٍ للأمّة. فكلاهما تصرف وفق المصلحة الإلهيَّة العليا التي اقتضت في زمن الأول الصبر وحفظ البقية، وفي زمن الثاني الفداء والتضحية.
إذن، كان لكلِّ إمامٍ دوره في حفظ الإسلام: فحيث اقتضت الحكمة الصبر، صبر أمير المؤمنين، وحيث تطلَّبت المصلحة الفداء، ضحى الحسين وأهل بيته، ليكونا معاً امتداداً لمشروعٍ واحدٍ هدفه إحياء الأمة.
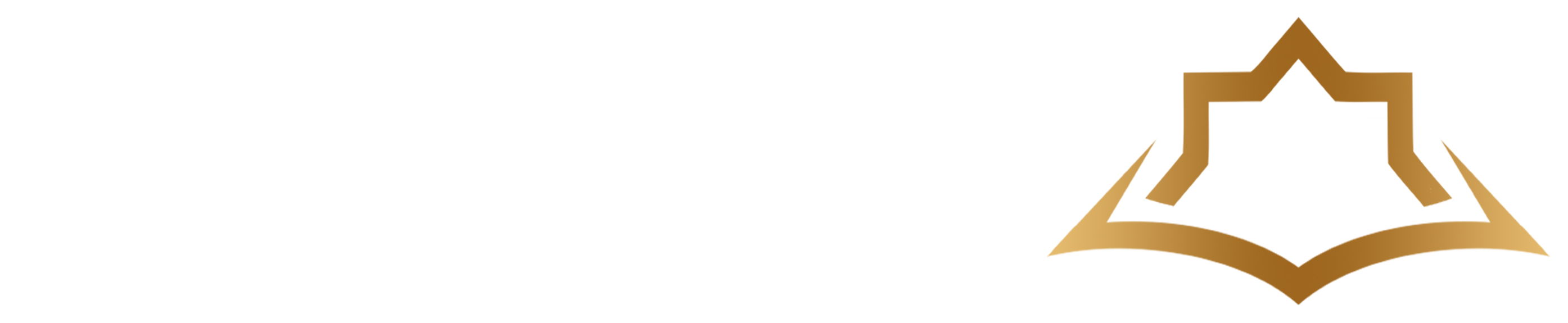


اترك تعليق