معنى قوله تعالى: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا﴾
السؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا﴾ [التوبة: 51].
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء لابأس أنْ يعلم السائل الكريم بأنَّ الآية ـ مورد السؤال ـ واردةٌ في سياق قوله تعالى: ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ * قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:50 ـ51].
والظاهر ـ من ألفاظ الآية وكلمات المفسِّرين ـ أنَّ جمعاً من المنافقين كانوا يستاؤون فيما إذا أصاب النبي (صلَّى الله عليه وآله) وأصحابه الخير والنصر، بينما كانوا يفرحون إذا أصابهم البلاء والشدَّة؛ لذلك قررتْ الآية المباركة أنَّ كلَّ ذلك - الخير أو الشر - من عند الله تعالى.
قال الطبريُّ: (القول في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾، يقول تعالى ذكره لنبيه محمَّد (صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم): يا محمَّد، إنْ يصبك سرورٌ بفتح الله عليك أرض الروم في غزاتك هذه يسوء الجدَّ بن قيس ونظراءه وأشياعه من المنافقين. وإنْ تصبك مصيبةٌ بفلول جيشك فيها، يقول الجدُّ ونظراؤه: ﴿قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ﴾، أيْ: قد أخذنا حذرنا بتخلُّفنا عن محمَّد وترك اتباعه إلى عدوِّه. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾، يقول: من قبل أنْ تصيبه هذه المصيبة. ﴿وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾، يقول: ويرتدُّوا عن محمَّد، وهم فرحون بما أصاب محمَّداً وأصحابه من المصيبة بفلول أصحابه وانهزامهم عنه، وقَتل من قُتل منهم....إلى قوله: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمؤْمِنُونَ﴾، يقول تعالى ذكره مؤدِّباً نبيه محمَّداً (صلَّى الله عليه [وآله] وسلَّم): قل يا محمَّد لهؤلاء المنافقين الذين تخلَّفوا عنك: ﴿لَنْ يُصِيبَنَا﴾ أيها المرتابون في دينهم ﴿إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا﴾ في اللوح المحفوظ وقضاه علينا..) [تفسير الطبريّ ج11 ص494 ـ495].
وقال الطبرسيُّ - في الآية مورد السؤال -: (﴿قُلْ﴾ يا محمَّد لهم: ﴿لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا﴾ أي: كلُّ ما يُصيبنا من خيرٍ أو شرٍ فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ في أمرنا، وليس على ما تظنُّون وتتوهَّمون من إهمالنا من غير أنْ يرجع أمرنا إلى تدبير، عن الحسن.
وقيل: معناه لنْ يصيبنا في عاقبة أمرنا إلَّا ما كتب الله لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا، وأنَّا نظفر بالأعداء، فتكون النصرة حُسنى لنا، أو نُقتل فتكون الشهادة حُسنى لنا أيضاً) [مجمع البيان ج5 ص67].
دفعُ وهم:
هذا ولا ينبغي توهُّم (الجبر) في هذه الآية المباركة، باعتبار أنَّ كلَّ شيءٍ أصابنا فهو من عند الله تعالى فنحن مجبورون عليه، ولا خيار لنا فيه أبداً، وذلك لبطلان عقيدة (الجبر) التي تؤول بالنتيجة إلى القول بالظلم- والعياذ بالله- بل معنى ذلك أنَّ جميع أفعال الإنسان مقدورةٌ لله تعالى وجاريةٌ تحت سلطنته، فكما أنَّ الجبر مرفوضٌ، كذلك التفويض مرفوضٌ؛ لأنّه يؤدِّي إلى تحديدٍ في دائرة سلطنته المطلقة.
قال الشيخ مكارم الشيرازيُّ - في ذيل الآية المباركة -: (مما لا شك فيه أنَّ مآلنا وعاقبة أمرنا ـ بأيدينا ـ ما دام الأمر يدور في دائرة سعينا وجدِّنا، والقرآن الكريم يصرِّح بهذا الشأن أيضاً، كقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، وكقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، وفي آياتٍ أُخر- بالرغم من أنَّ الجدَّ والسعي هما من السنن الإلهية وبأمره تعالى أيضاً- إلَّا أنَّه عند خروج الأمر عن دائرة سعينا وجدِّنا، فإنَّ يد القدر هي التي تتحكَّم بمآلنا وعاقبة أمرنا، وما هو جارٍ بمقتضى قانون العليَّة الذي ينتهي إلى مشيئة الله وعلمه وحكمته وهو مقدَّر علينا، فهو ما سيكون ويقع حينئذٍ، غاية ما في الأمر أنَّ المؤمنين بالله وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته، يفسِّرون هذه المقادير بأنها جاريةٌ وفقاً «للنظام الأحسن» وما فيه مصلحة العباد، وكلٌّ يُبتلى بمقادير تناسبه حسب جدارته التي اكتسبها. فالجماعة، إذا كانوا من المنافقين الجبناء والكسالى والمتفرقين فهي محكومةٌ بالفناء حتماً. إلَّا أنَّ الجماعة المؤمنة الواعية المتحدة المصممة، ليس لها إلَّا النصر والتوفيق مآلاً. فبناءً على ذلك يتَّضح أنَّ الآيات ـ آنفة الذكر ـ لا تنافي أصل الحرية ـ حرية الإرادة والاختيار ـ وليست دليلاً على العاقبة الجبرية للإنسان أو أنَّ سعي الإنسان لا أثر له) [تفسير الأمثل ج6 ص78].
وقال الميرزا التبريزيُّ - في جواب سؤالٍ وجِّه إليه -: (إنَّ القضاء والقدر على قسمين: الأوَّل: ما كان معلَّقاً على اختيار العبد، كالخسارة والربح مثلاً، فهذا راجعٌ لمشيئة الإنسان، وعِلْم الله بوقوعه عن اختيار العبد ليس سبباً لإجبار العبد على ممارسة ذلك العمل.
والثاني: ما كان غير معلَّقٍ على مشيئة العبد، فهذا قضاءٌ حتميٌّ، كالغنى والفقر والآجال، وأمثالها مما ليس بيد العبد، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم في نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ الله لَنا﴾ [التوبة: 51]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْناه فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]، والمقصود بليلة القدر ـ كما في الروايات ـ ليلة التقدير، أي تقدير الأرزاق والآجال ونحوها. إنَّ تقدير الله بعد اختيار العبد كسب الحرام، وقضاءه بعد تقدير العبد سلوكه. وإنْ شئت قلت: قضاؤه وتقديره مسبوقٌ بعلمه سبحانه، وما تعلَّق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته، فلا منافاة بين قضاء الله واختيار العبد، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء الله، بل هما متطابقان، والله العالم) [الأنوار الإلهيَّة ص77].
والنتيجة من كلِّ ما تقدَّم، أنَّ الآية المباركة تُشير إلى أنَّ كلَّ ما يُصيب الإنسان من الخير أو الشر والمنافع والمضارّ فهو من عند الله تعالى وداخل تحت سلطنته، كما أنَّها لا تعني بذلك الجبر والاضطرار، كما أوضحنا..
والحمد لله ربِّ العالمين.
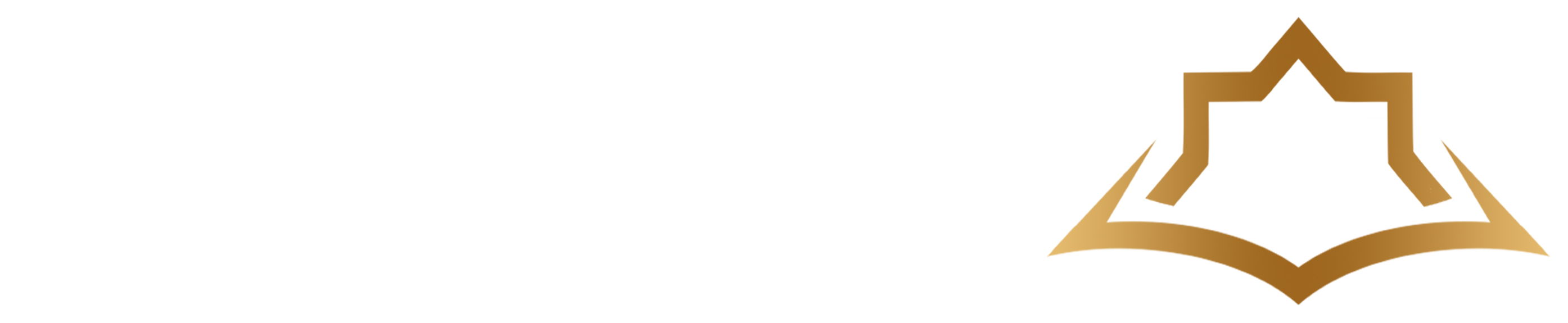


اترك تعليق