معايير تمييز التعاليم الإلهيَّة عن الأهواء البشريّة
ما هي المعايير العابرة للثقافات التي تسمح بتمييز "التعاليم الإلهيَّة الحقيقيّة" من "الأهواء البشريّة "؟ إذا كان الخالق موجوداً، فلماذا يترك البشريّة في متاهةٍ تأويليَّةٍ لا تنتهي، حيث كلُّ فريقٍ يدّعي احتكار الحقيقة؟ كيف يستقر العقل البشريّ في يقينياته إيماناً أو إلحاداً رغم أنَّ كليهما مبنيٌّ على مقدّماتٍ غير قابلة للإثبات؟
الجواب:
السؤال يدمج بين أكثر من إشكالٍ معرفيّ وفلسفيّ، ويتضمن في صياغته بعض الافتراضات التي تحتاج إلى مراجعةٍ قبل القبول بها كمسلّمات، مثل فكرة غياب المعايير الموضوعيَّة، أو تساوي الإيمان والإلحاد من حيث قوة الأساس المعرفيّ، وحتى يتضح ما فيه من مغالطاتٍ أو خلط ٍسنجيب عن كلِّ إشكالٍ منها على حدة.
السؤال الأول: ما هي المعايير العابرة للثقافات التي تسمح بتمييز التعاليم الإلهيَّة الحقيقيّة من الأهواء البشريّة؟
الجواب: عندما نتحدّث عن معايير عابرة للثقافات، فنحن نشير إلى مقاييس عقليَّة ومنطقيَّة وأخلاقيَّة يمكن أنْ يُجمع عليها الإنسان من حيث كونه إنساناً، بغض النظر عن خلفيته الدينيَّة أو الثقافيَّة. وهذه المعايير لا بد أنَّ تقوم على أسسٍ ثلاثة:
1ـ الاتساق الداخليّ: وهو أنْ تكون التعاليم المنسوبة للوحي متَسقةً في ذاتها، غير متناقضة، وهو مما يدلُّ على وحدة المصدر وعصمته من التناقض والتهافت، وهذا ما نجده واضحاً في قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً} [النساء: 82]
2ـ الاتساق مع الفطرة الإنسانيَّة: أي أنْ تنسجم التعاليم مع المبادئ الأخلاقيَّة والعقليَّة الراسخة في الفطرة، مثل: العدل، والرحمة، وكرامة الإنسان، والتكليف المسؤول، ما يعني أنَّ الوحي لا يمكن أنْ يدعو إلى الظلم أو الفساد أو العبث. يقول تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]. فهذه الآية تُقرّر أنَّ الدين القيم - أي المنهج الإلهيّ - مؤسَّسٌ على الفطرة، وليس مناقضاً لها، بل هو امتدادٌ لها وتفعيل لمقتضياتها. وهذا يؤكد أنَّ الوحي الإلهيَّ لا يصطدم بالبنية الأخلاقيَّة والعقليَّة الراسخة في الإنسان، بل يعززها ويهذبها ويوجهها.
3ـ الفاعليَّة الحضاريَّة والروحيَّة: الوحي الحقيقيّ ليس مجرد كلماتٍ نظرية، بل هو ما يصنع تحولاً حقيقياً في الإنسان والمجتمع، يرتقي به أخلاقياً وروحياً، ويدفع نحو الاستقرار والتنمية بدلاً من الفوضى والانحلال، والعقل قادرٌ على التمييز بين الدعوات التي تؤدّي إلى نتائج حضاريَّةٍ وإنسانيَّةٍ، وتلك التي تؤدّي إلى التدمير أو العبث. وقد وصف الله تعالى الوحي بقوله: {قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [المائدة: 15-16]، مبيناً أنَّ هذه الدعوة الإلهيَّة ليست مجرد نظريةٍ، بل هي دعوةٌ لإحياء الإنسان في جميع جوانب حياته، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]. وقد جاء الوحي ليعزّز هذه الحياة ويجنّب الأرض الفساد، كما قال الله تعالى: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 77].
الذي يحمل طابعاً متجاوزاً للزمن والمكان، وبين (الأهواء البشريّة) التي تتلوّن بالأمزجة والمصالح، وتتبدل بحسب الظروف.
الوحي يُحدث قفزةً نوعيَّةً في الوعي، أما الهوى فغالباً ما يؤدّي إلى التشتت والتيه.
السؤال الثاني: إذا كان الخالق موجوداً، فلماذا يترك البشريّة في متاهةٍ تأويليَّةٍ لا تنتهي؟
الجواب: هذا السؤال يفترض أنَّ الخالق ترك البشر دون هدايةٍ واضحة، وهو افتراضٌ غير دقيق؛ لأنّ الفكرة الأساسيَّة - التي يطرحها الدين عموماً، والإسلام خصوصاً - هي أنَّ الله أرسل أنبياءً في كلّ أمةٍ بلسان قومهم؛ ليكون البلاغ واضحاً غير ملتبس. وما نراه اليوم من اختلافٍ في التأويل ليس دليلاً على غموض الرسالة، بل هو نتيجةٌ طبيعيَّةٌ لعوامل بشريَّةٍ: كالتعصّب، والمصالح، والانقطاع عن مصادر الهداية، وتراكم التأويلات التاريخيَّة.
ثم إنَّ التعدد لا يعني بالضرورة غياب الحق، كما أنَّ وجود تفاسير مختلفةٍ للظواهر الطبيعيَّة لا ينفي وجود قوانين علميَّةٍ حقيقيَّة، بل يدعو إلى بذل مزيدٍ من الجهد لكشفها.
فالله -بحسب ما تقرّره النصوص القرآنيَّة - لم يترك الناس في المتاهة، بل ترك لهم العلامات الواضحة، ولكن من الناس من يطمسها، ومنهم من يهتدي بها، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ [الأنعام: 104].
أما عن الحكمة من هذا الابتلاء التأويلي، فهي تربية الإرادة الحرة، وتنمية ملكة البحث عن الحقيقة؛ لأن الإيمان لا قيمة له إنْ لم يكن وليد وعيٍّ واختيار، لا مجرد تقليدٍ أعمى أو إكراهٍ إلهيّ.
السؤال الثالث: كيف يستقر العقل البشريّ في يقينياته، إيماناً أو إلحاداً، رغم أنَّ كليهما مبنيٌّ على مقدّماتٍ غير قابلةٍ للإثبات؟
الجواب: هذا السؤال يخلط بين نوعين من البرهان: (البرهان التجريبيّ) الذي يقوم على الملاحظة والتكرار، و(البرهان العقليّ) الذي يُبنى على التحليل المنطقيّ والفطريّ. وجود الخالق، مثلاً، لا يُثبت بالتجربة المخبريّة، ولكنه يُثبت بالعقل عبر التأمل في النظام، والغاية، والعلّة الأولى، تماماً كما نُثبت وجود العقل أو الأخلاق أو الحبّ، دون أنْ نضعها تحت المجهر.
أما الادعاء - بأنَّ الإيمان والإلحاد في المرتبة نفسها؛ لأنَّ كليهما لا يمكن إثباته تجريبياً - فهو مغالطةٌ في الفهم.
فالإيمان يعتمد على أدلَّةٍ عقليَّةٍ وتجريبيَّةٍ غير مباشرة، منها دقّة النظام الكونيّ، ووجود القوانين الثابتة، والشعور الأخلاقيّ الفطريّ، والتجربة الوجدانيَّة المشتركة للبشر، بالإضافة إلى الشواهد التاريخيّة للنبوّات والوحي. هذه كلها تشكّل معاً سياقاً عقلانيَّاً قوياً يجعل الإيمان خياراً منطقياً ومُبرّراً.
أما الإلحاد، فهو لا يقدّم تفسيراً بديلاً لهذه الظواهر، بل يقوم غالباً على نفي وجود خالقٍ دون أنْ يستطيع إثبات هذا النفي.
ومن المعروف في المنطق أنَّ "نفي وجود شيءٍ" لا يمكن إثباته بشكلٍ قاطع؛ لأنَ عدم وجود الدليل عليه لا يعني بالضرورة أنَّه غير موجود. فالعجز عن الإدراك لا يعني العدم؛ ولهذا، فإن كفّة الإيمان – من الناحية العقليَّة – ليست مساويَّةً للإلحاد، بل أرجح منه، لأنَّه مبنيٌّ على ترجيحٍ إيجابيٍّ مستندٍ إلى شواهد متعدّدة، لا على مجرّد غياب القناعة.
وبالتالي، فالعقل البشريّ لا يطمئن إلى الإيمان أو الإلحاد بلا مقدّمات، بل بحسب قدرة كلّ فردٍ على التعامل مع المعطيات وتفسيرها. لكن ما يُرجّح كفة الإيمان هو أنَّ تفسيراته للوجود أكثر شمولاً ومعقوليَّةً واتساقاً مع الفطرة.
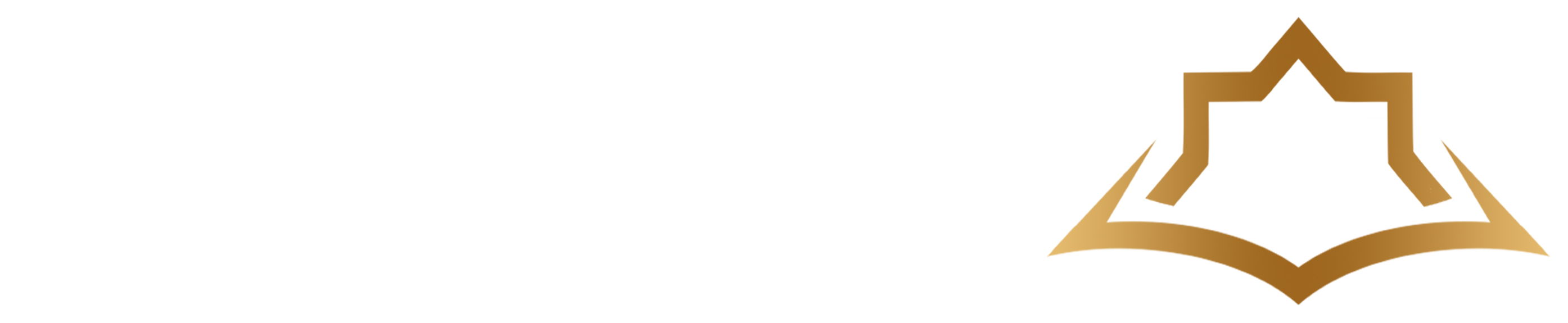


اترك تعليق