عثمان.. ذلك الأمويّ الذي أظهر المَنَّ بإسلامه!
السؤال: فيمن نزلت آية: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا..}. وما سبب نزولها؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
يريد السائل الكريم قوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الحجرات: 17]، وقبل معرفة مَن نزلت فيه، لابدّ من التوطئة ببيان معنى الآية الشريفة، وقد ذكر المفسّرون من الفريقين ما حاصله: أنّ هنالك بعض الصحابة ممّن أظهروا الإسلام كانوا قد امتنّوا بإسلامهم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأخطأُوا في ذلك من وجهين:
أحدهما: ليس للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أمر الدين شيء، وإنّما هو رسولٌ مأمورٌ بالتبليغ، فلا مَنَّ عليه لأحدٍ مِمَّن أسلم عليه؛ لذا قال تعالى: {قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ}. ولو كان هناك مَنٌّ لكان على الله سبحانه؛ لأنّ الدين دينه تعالى.
والآخر: حقيقة النعمة التي فيها المنُّ هي نعمة الإيمان؛ فإنّه مفتاح سعادة الدنيا والآخرة دون الاسلام الذي ليست له إلّا الفوائد الدنيويّة، كحقن الدماء وجواز المناكح والمواريث؛ ولذا قال تعالى: {بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ}، ولم يقل: (هداكم للإسلام) [ينظر: تفسير الميزان ج18 ص330، تفسير الرازيّ ج28 ص143].
فإذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه لابدّ لهذا الامتنان من أسبابٍ ودوافع، والمستفاد من أخبار وروايات أصحابنا أنّ الآية الشريفة نازلةٌ في عثمان بن عفّان، بسبب الحادثة التي جرت بينه وبين عمّار بن ياسر، وهل كانت الحادثة حين بناء المسجد النبويّ الشريف على أثر وصول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مهاجراً إلى المدينة؟ أم عند حفر الخندق في السنة الخامسة للهجرة الشريفة؟، اختلفت الروايات في ذلك:
فمن روايات نزولها عند بناء المسجد ما رواه الكَشيّ عن محمود بن مسعود العيّاشيّ بإسناده عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليٌّ وعمّارٌ يعملون مسجداً فمرّ عثمان في بِزّةٍ له يخطر، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) [أي قال لعمّار]: أرجز به، فقال عمّار:
لا يستوي من يعمر المساجدا ** يظل فيها راكعاً وساجدا
ومن تراه عانداً معاندا ***عن العباد لا يزال حائدا
قال: فأتى النبيَّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: ما أسلمنا لِتُشتم أعراضنا وأنفسنا، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أَفَتُحبُّ أَنْ تُقال؟ فنزلت آيتان: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا.. الآية} ، ثمّ قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لعليٍّ (عليه السلام): اكتب هذا في صاحبك، ثمّ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): اكتب هذه الآية : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.. الآية: 15}» [رجال الكَشيّ ص138].
وعلق المحقّق الداماد في حاشيته على الكتاب في معنى الرواية: (قوله (صلى الله عليه وآله): «اكتب هذا في صاحبك»: أي في عمّار ، و«هذا» إشارة إلى ما أمر بكتابته وهو: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، أو في عثمان فيكون «هذا» إشارة إلى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}، والمعنى: اكتب {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} في عثمان ، و {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا} في عمار) [المصدر السابق].
وفي المقابل جاء في تفسير عليّ بن إبراهيم القميّ نزولها حينما كان المسلمون يشاركون رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في حفر الخندق استعداداً للمعركة، فأبى عثمان أنْ يشاركهم في الحفر وأَنِفَ من ذلك واستكبر، حتّى صار يتحاشى أنْ يصيبه شيءٌ من الغبار المتطاير، فأنشد عمّار بن ياسر تلك الأبيات التي فهم منها عثمان أنّها تعريضٌ به وطعنٌ فيه، فشتمَ عمّاراً، ثمّ قصد إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مغضباً، فمَنَّ عليه بإسلامه واتّباعه له؛ ولذا أقاله النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأذِنَ له بالرحيل وترْكِ الإسلام، فنزلت الآية.
قال القميّ: (وقوله: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا...} نزلت في عثمان يوم الخندق، وذلك أنّه مرَّ بعمّار بن ياسر وهو يحفر الخندق، وقد ارتفع الغبار من الحفر فوضع [أي عثمان] كُمَّهُ على أنفه ومرّ، فقال عمار:
لا يستوي مَن يبني المساجدا * يصلّي فيها راكعاً وساجدا
كَمَن يمرّ بالغبار حائدا * يعرض عنه جاحداً معاندا
فالتفت إليه عثمان فقال: يا ابن السوداء، إيّاي تعني؟ ثمّ أتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له: لم ندخل معك لِتُسبَّ أعراضُنا، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «قد أقلتك إسلامك، فاذهب»، فأنزل الله: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا..}) [تفسير القميّ ج2 ص322].
وروى الشيخ هاشم بن محمد [من أعلام القرن السادس] عن جابر بن عبد الله، قال: «كنت مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حفر الخندق، وقد حفر الناس، فحفر عليٌّ (عليه السلام)، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): بأبي مَن يحفر وجبرائيل يكنس التراب بين يديه وميكائيل يُعِينه، ولم يكن يُعِين أحداً قبله من الخلق، ثمّ قال لعثمان بن عفان: احفِر، فغضب عثمان، وقال: لا يرضى محمّدٌ أَنْ قد أسلمنا على يده حتّى يأمرنا بالكدّ، فأنزل الله على نبيّه: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [مصباح الأنوار (مخطوط) ص97].
ولا تعارض بين هذه الرواية وسابقتها؛ إذ يمكن أن يكون ما في رواية جابر بن عبد الله من رفض عثمان للحفر وعدم إطاعته لأوامر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قد حصل أوّلاً، فلمّا سمع عمّار بذلك أنشد الأبيات، فحصل ما في رواية القميّ من شتم عثمان له ونعته بابن السوداء.
والجدير بالذكر هنا أنّ اختلاف الروايات في وقت نزول الآية الشريفة يمكن أنْ يكون ناشئاً من تعدّد الحادثة وتكرر نزول الآية، فقد اتّفق علماء التفسير من الفريقين على إمكان نزول الآية الواحدة عدّة مرّات، وذكروا لذلك عدّة شواهد، مثل تكرار نزول سورتي الفاتحة والإخلاص، وأواخر سورة النحل، وأوّل سورة الروم، وغير ذلك ممّا أوضحه السيوطيّ مفصّلاً. [ينظر: الإتقان في علوم القرآن ج1 ص140]. كما اتفقوا أيضاً على إمكان تعدّد أسباب النزول مع وحدة ما نزل، وقد فصّل الكلام في ذلك شيخ السلفيّة منّاع خليل القطّان. [ينظر: مباحث في علوم القرآن ج1 ص83].
وفي ذلك يقول السيّد محمّد باقر الحكيم (قُدّس سرّه): (وفي حالة تعدّد السبب، قد يوجد فاصلٌ زمنيٌّ كبيرٌ بين أحد السببين والآخر، فيؤدي السبب الأول إلى نزول الآية فعلاً، ثمّ يتجدّد نزولها حينما يوجد السبب الثاني بعد ذلك بمدة، فيكون السبب متعدّداً والنزول متعدّداً وإن كانت الآية النازلة في المرتين واحدة) [علوم القرآن ص41].
هذا كلّه بحسب الروايات والأخبار المستفادة من كتبنا، وأمّا ما في كتب علماء السنّة، فقد اقتصروا على نقل حادثة الخلاف الأولى بين عمّار وعثمان، دون ذكر قصّة امتنان عثمان أو نزول الآية فيه، بل قد تكتّموا حتّى على اسمه فلم يصرّحوا به؛ وذلك عملاً بمنهجهم المتّفق عليه بينهم من إخفاء مثالب الصحابة وخصوصاً بني أميّة، وبالأخصّ منها مثالب عثمان بن عفّان.
ففي سيرة ابن هشام [ت213هـ] عن ابن إسحاق [ت151هـ] في معرض حديثه حول بناء المسجد النبويّ قال: (وارتجز عليّ بن أبي طالب (رض) يومئذٍ: لا يستوي مَن يعمر المساجدا.. الأبيات، فأخذها عمّار بن ياسر، فجعل يرتجز بها. قال ابن هشام: فلمّا أكثر، ظنّ رجلٌ من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أنّه إنّما يعرّض به، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكّائيّ عن ابن إسحاق، وقد سمّى ابنُ إسحاق الرجلَ. قال ابن إسحاق: فقال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سميّة، والله إنّي لأُراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله (ص)، ثمّ قال: «ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار، إنّ عماراً جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه ») [السيرة النبويّة ج2 ص344].
وكما ترى، فقد أخفى ابن هشام اسم عثمان!، وقد علّق السُهيليّ على ذلك قائلاً: (وكره ابن هشام أن يسمّيه كي لا يَذكر أحداً من أصحاب رسول الله (ص) بمكروه!، فلا ينبغي البحث عن اسمه!!) [الروض الأنِف ج4 ص160]. ولكنّ القاضي أبا ذر الخشنيّ - أحد أبرز علماء الحديث عندهم - كشف الحقيقة حينما صرّح بأنّه عثمان بن عفّان!. [ينظر: الإملاء المختصر ص135].
وكيفما كان، فإنّ اكتفاء القوم بذكر الحادثة الأولى وعدم ذكرهم للثانية لا يقدح بأصل الموضوع ولا ينفي الحقيقة بعد الذي عرفت من إمكان تكرار نزول الآية أو تعدّد سبب نزولها، كما أنّ اقتطاع القوم لبقيّة القصة لا يضرّ بإثبات صدور ما هو مثلبةٌ وسيّئةٌ من قِبَل عثمان، وإلّا لما كره القوم ذكرها ولا كرهوا التصريح باسمه؛ بل لو لم تكن سيئة ومثلبة قبيحة لما كان هنالك ما يدعو عمّاراً لأن يرتجز بهذه الأبيات، ولا ما يجعل عثمان خاصة دون سائر المسلمين يظن أنّه هو المعنيّ بها فيغضب، فتنبّه جيّداً.
ومن الواضح أنّه ليس غريباً على عثمان صدور الامتنان منه؛ فإنّه من بني أميّة الذين دخلوا إلى الإسلام كرهاً، وخرجوا منه طوعاً، كما هو صريح كلمات أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة في حقّهم، وإليك بعضاً منها:
فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه لمعاوية، قال: «فأنا أبو حسنٍ قاتل جدّك وخالك وأخيك شدخاً يوم بدر، وذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى عدويّ، ما استبدلت دِيناً، ولا استحدثت نبيّاً، وإنّي لَعَلَى المنهاج الذي تركتموه طائعين، ودخلتم فيه مكرَهين» [نهج البلاغة ص370].
وفي كتابٍ آخر له (عليه السلام) قال: «أما بعد، فإنّا كنّا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرّق بيننا وبينكم أمسِ: إنّا آمنّا وكفرتم، واليومَ: إنّا استقمنا وفُتنتم. وما أَسلمَ مُسلمكم إلّا كَرهاً، وبعد أن كان أنف الإسلام كلُّه لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) حزباً» [نهج البلاغة ص454].
وروى البلاذريّ عن الحسن البصريّ: أنّه لمّا آلت الأمور بالإمام الحسن (عليه السلام) إلى عقد الصلح مع معاوية ووصل الخبر لقيس بن سعد بن عبادة، خرج إلى أصحابه فقال: «يا قوم، إنّ هؤلاء القوم كذّبوا محمّداً وكفروا به ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فلمّا أخذتهم الملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم دخلوا في الإسلام كرهاً، وفي أنفسهم ما فيها من النفاق، فلمّا وجدوا السبيل إلى خلافه، أظهروا ما في أنفسهم!» [أنساب الأشراف ج3 س52].
كما روى ابن عساكر عن أبي هارون المدينيّ، قال: «قال معاوية لقيس بن سعد: إنّما أنت حبر من أحبار يهود، إنْ ظهرنا عليك قتلناك، وإنْ ظهرت علينا نزعناك، فقال: إنّما أنت وأبوك صنمان من أصنام الجاهليّة، دخلتما في الإسلام كرهاً، وخرجتما منه طوعاً» [تاريخ دمشق ج49 ص430].
فتحصّل من مجموع ما تقدّم، أنّ الآية نازلة في ذمّ عثمان بن عفّان زعيم بني أميّة الخارجين عن الإسلام طوعاً، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
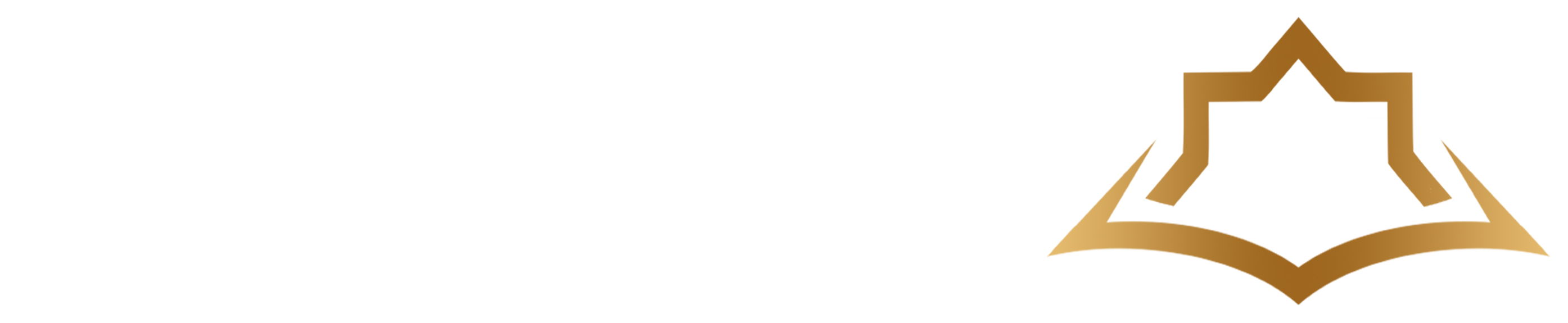


اترك تعليق