علم المعصوم بمعالجة الأوبئة
السؤال: انتشرت الكثير من الأمراض في زمن المعصومين (ع) واستمرت حتى بعد وفاتهم. ما الذي يمنع من أنْ يصفوا علاجاتٍ فعَّالةً لهذه الأوبئة، خاصة وإنَّ علمهم كان شاملاً؟ لماذا انتظرنا قدوم الغرب للقضاء على أمراض مثل الطاعون أو السلِّ وغيرها؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال المتعلّق بعدم معالجة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) للأوبئة المنتشرة في عصورهم ينطوي على مغالطةٍ منطقيّةٍ تستوجب التوضيح. إذ يُفترض ضمنًا أنَّ غياب سجلّاتٍ تفصيليّةٍ توثق تلك المعالجات يُعدّ دليلاً على انعدام معرفة الأئمّة (عليهم السلام) بالطبّ أو عدم اهتمامهم به، وهو استنتاجٌ غير سليم من عدّة وجوه:
أوّلاً: إنّ عدم توفّر وثائق طبيّةٍ مفصّلةٍ من تلك الفترة لا يعني بالضرورة غياب المعرفة الطبيّة أو الممارسات العلاجية، بل قد يرجع ذلك إلى محدوديّة التوثيق أو فقدان كثيرٍ من المصادر بمرور الزمن. ومع ذلك، فإنّ التراث الإسلاميّ يحتفظ بعددٍ من النصوص التي تعكس اهتمام الأئمّة (عليهم السلام) بالقضايا الصحيّة وامتلاكهم قدراً عالياً من المعرفة الطبيَّة.
ومن أبرز الشواهد على ذلك: رسالة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) المعروفة بـ(الرسالة الذهبيّة) أو (طبّ الرضا)، والتي تتضمّن جملةً من المبادئ الطبيّة والتوصيات الصحيّة التي تدلّ على إلمامٍ دقيقٍ بطبّ الأبدان وطرائق الوقاية والعلاج.
وقد جمع العلماء العديد من هذه النصوص في كتب مثل: (طبّ الأئمّة) للسيد عبد الله شبر، و(طبّ الأئمّة) لعبد الله بن سابور الزيّات، والحسين بن بسطام النيسابوريّ. كما خُصِّص الجزء (59) من موسوعة (بحار الأنوار) للطب، حيث وردت فيه رواياتٌ متعدّدةٌ تتناول الجوانب الوقائيّة والعلاجيّة للأمراض المنتشرة في ذلك الزمن. ويمكن مراجعة ما ذكره الشيخ آغا بزرك الطهراني في [الذريعة ج15 ص140، وج18 ص8] حول مصادر الطبّ الإماميّ وتوثيقها.
ثانياً: لا بدّ من التمييز بين امتلاك المعرفة وإمكان تطبيقها في الواقع العمليّ، فإنّ الأئمة (عليهم السلام) – بحسب ما تقرّره العقيدة الإماميّة – كانوا على اطّلاعٍ تامٍّ بالعلوم، ومنها علم الطب، غير أنّ توفّر المعرفة لا يلازم بالضرورة إمكانية توظيفها في جميع الظروف، خاصّة في مجتمعات تحكمها اعتباراتٌ سياسيَّةٌ ودينيَّةٌ واجتماعيَّةٌ معقّدة، فقد عاصر الأئمّة (عليهم السلام) أنظمةً حاكمةً كانت تُضيّق عليهم الخناق، وتمنعهم من ممارسة دورهم العلميّ والاجتماعيّ بحريةٍ تامّةٍ، الأمر الذي يفسّر غياب التأثير الظاهريّ المباشر في بعض المجالات التطبيقيّة، ومنها المجال الطبّي.
ثالثاً: ينبغي فهم دور الإمام ضمن إطار تكليفه الإلهيّ، فإنّ مهمّة الإمام الأساسيّة - بحسب المنظور الإماميّ - لا تتمثّل في القيام بجميع الأدوار التخصّصيّة نيابةً عن المجتمع، بل في هداية الناس وتبليغ الأحكام وبيان طريق الكمال، مع إلقاء الأصول الكلّية التي تُرجع إليها التفاصيل، كما ورد في الرواية المعروفة: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع». [مستطرفات السرائر ص109]. فكما لا يُنتظر من الإمام أنْ يكون مهندساً أو نجاراً يمارس المهنة فعلاً، لا يصحّ افتراض أنَّ عدم تدخّله المباشر في معالجة الأوبئة دليلٌ على تقصيرٍ أو جهل، بل الأمر يتعلّق بتحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليَّات داخل الأمة.
رابعاً: من منظورٍ إيمانيّ، ثمّة بُعدٌ غيبيٌّ في ظهور الأوبئة وانتشارها، فقد أشارت العديد من النصوص إلى أنّ بعض الأمراض قد تكون عقوبةً إلهيَّةً أو وسيلةً للاختبار أو الابتلاء، ممّا يجعل التعامل معها لا يقتصر على الجانب الطبّي المادّي فحسب، بل يشمل الجوانب الأخلاقيَّة والسلوكيَّة والدينيَّة أيضاً. ومن هنا نجد أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كثيراً ما ركّزوا على أسباب الوقاية الروحيَّة والسلوكيَّة إلى جانب الوقاية الجسديَّة، كما يظهر في توصياتهم في مجالات النظافة والطهارة والتغذية والتوازن النفسي، فقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «خمسٌ إنْ أدركتموهن فتعوّذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قومٍ قطُّ حتّى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدّة المؤون وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلّا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلّا سلط الله عليهم عدوّهم وأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله عزّ وجل إلّا جعل الله عزّ وجلّ بأسهم بينهم» [الكافي ج2 ص373]. وورد أنّه: «قيل للصادق (عليه السلام): أخبرنا عن الطاعون، فقال: عذابٌ لقومٍ، ورحمةٌ لآخرين...» [علل الشرائع ج١ص٣٣٦]، وورد: «وإنّه رجز عُذِّب به بعض الأمم قبلكم» [مجمع البيان ج1 ص230].
يتّضح من خلال ما تقدّم: أنّ الإشكال المطروح على تعامل الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) مع الأوبئة لا يستند إلى أساسٍ علميٍّ أو تاريخيٍّ متين، بل يقوم على فرضيّاتٍ غير دقيقة، تتجاهل طبيعة الظروف التاريخيّة، وتخلط بين امتلاك المعرفة وإمكانيّة ممارستها فعليّاً، كما أنّ غياب التوثيق الكامل لا يُعدّ دليلاً على غياب الفعل، خصوصاً مع وجود مصادر تراثيَّةٍ معتبرة توثّق اهتمام الأئمّة بالطب وحرصهم على الوقاية والعلاج في ضوء الإمكانات المتاحة.
وعليه، فإنّ التعامل مع مثل هذه التساؤلات يتطلّب وعياً بمناهج البحث التاريخي، وفهماً دقيقاً لدور الإمام في الفكر الإمامي، إضافةً إلى تمييز الجوانب الغيبيَّة والتربوية التي ارتبط بها موقف المعصوم من الظواهر الطبيعية والاجتماعية، ومن هذا المنظور، لا يكون غياب دورٍ ظاهريٍّ مباشرٍ في بعض المجالات مدّعاةً للطعن في علم المعصوم، بل هو من مقتضيات الحكمة والسنن الإلهيَّة في إدارة شؤون الخلق، حيث تتكامل الأدوار بين الهداية والتعليم، وبين الابتلاء والتمكين.
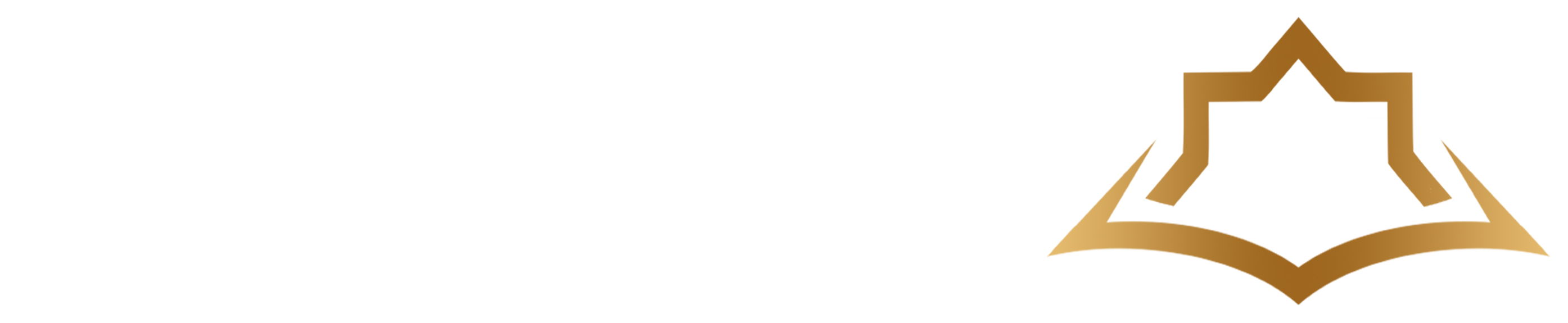


اترك تعليق